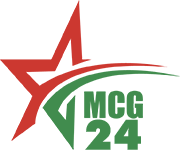ميارة: مأسسة الحوار الاجتماعي مكسب كبير للشغيلة المغربية
أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أمس الأحد بوجدة، أن مأسسة الحوار الاجتماعي يشكل مكسبا كبيرا للطبقة الشغيلة المغربية.
وقال السيد ميارة، خلال لقاء تواصلي عقده مع مناضلي الاتحاد العام بجهة الشرق، بحضور مسؤولين مركزيين وجهويين من النقابة وحزب الاستقلال، إن الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الحكومة في 30 أبريل الماضي بشأن الحوار الاجتماعي، يشكل خطوة مهمة نحو مأسسة هذا الحوار لخدمة مصالح الشغيلة المغربية.
وأضاف أن مأسسة الحوار الاجتماعي كانت دائما مطلبا مهما للحركة النقابية الوطنية، من أجل إقامة هذا الحوار على أساس متين وبشكل منتظم وضمان فعاليته وشفافيته، سواء تعلق الأمر بالقضايا المتعلقة بالحركة النقابية أو القطاعين الخاص والعام.
من جهة أخرى، اعتبر السيد ميارة أن الحفاظ على مناصب الشغل يمثل أولوية في ظل السياق الدولي الحالي، داعيا إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة ارتفاع مختلف أسعار السلع والخدمات.
وأشار في تصريح للصحافة، إلى أن هذا اللقاء التواصلي يعتبر السادس في سلسلة اللقاءات الجهوية المنظمة في كافة جهات المملكة، بهدف اطلاع مناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على مستجدات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، في سياق اقتصادي يتسم بالأزمة العالمية وتداعيات الجفاف.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بلقاء المناضلين وتعبئتهم لمعالجة القضايا ورفع التحديات التي تواجه الطبقة الشغيلة المغربية.