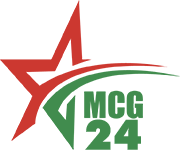في بهاء اللغة الصوفية
«البهاء منتهى الجمال وكماله»
أحمد بن عجيبة
1) صبوة الإشارة
اللغةُ الصوفيةُ لغةُ حبٍّ ومحبّة، وهذا نسبُها الأول، لغةٌ تُشتقّ من جسد العاشقِ الصوفي، تنتشي بصبابتِه، ترتعشُ بوَجْدِه، وتَتَّزي عندَ الهجْرِ بالحِدَاد كما الجسدُ بالضمور. ومثلما يتعرّى المُحبّ من أعرافِ العُقلاء، فإن لغةَ الحب هاته تقطَع مع العقلُ، فهو عند الصوفية عقالٌ وسِجن، إنه حجابٌ كما هو شأنُ العبارة، العقلُ يحُول بين الصوفيّ وبين تذوّقه للدلالاتِ الروحية الباطنية، وكذلك العبارةُ تخُون تلك الدلالاتِ لأنها تَسْتُر هذه التجربةَ وتحجُبُها فيما هي تريدُ الإفصاحَ والتعبيرَ عنها، من هنا تمجيدُ المتصوفةِ للإشارةِ، فالإشارةُ لغةُ أذواقٍ ومواجيد؛ لغةٌ ينتظمها نحوُ القلوب. إنها محوٌ ونسيانٌ لتسلُّط العقل، وتفجيرٌ لمواجيد القلبِ وخلجاته العشقيّة ونبضاتِه الروحيّة الملتهبة. لغةُ الإشارة، بماهي لسانُ الباطن، تقُومُ على اختراقِ لغة الظاهر وتجاوزِها، إنها بجملةٍ تُعْلِنُ عن “موتِ لغة الظاهر” لتتحلّى اللغةُ الصوفيةُ بنشوةِ الوجدِ كما هو شأنُ باطنِ الصوفيّ، فتتفجّر إشاريتُها بمعرفةٍ لها الحدسُ والإشراقُ والكشفُ؛ معرفةٍ ذوقية روحانيةٍ تصدر عن تجربةٍ فردية باطنية باذخة. لغةُ الصوفي، إذن، لغةُ سرٍّ يُستبطَن بالحدس والذوقِ والتجربة الصوفية، ولا يُدرَك بالعقلِ والحِجا والمنطقِ المألوف. إنها لغةُ ذوقٍ وأحوالٍ لا لغةُ عقلٍ وجِدال، فالحبُّ يُذاق ولا يُعْقَلُ، واللغةُ عن قول هذا الحبّ قاصِرَة، أعني لغةَ العبارة؛ ذلك أن السرّ الصوفيّ ليس معنىً ماثِلاً، أو فكرةً ذهنيةً يمكنُ أن “تحمِلها” وتقولَها لغةُ العبارة. المعنى الصوفي كشفٌ “إذا عَبَر خَفِي”، من هنا يبدو أنّ اللغةَ الصوفيةَ الإشارية، بماهي لغةُ حبٍّ وسرٍّ، ليست وسيلةَ تواصلٍ وتبليغٍ، فهي ليست إفصاحاً عن فكرة، أو وعاءً لمعنى، أو جِسْراً لعبور دلالة؛ لأنها كَفَّت عن أن تكونَ “عبارة”. إنها إيماءٌ وتمليحٌ وليست لغةَ بلاغةٍ وتوضيح، بل ربّما كانت لغةً للحجبِ والتغليطِ والتعميّة؛ لغةً تمجّد الغموضَ، أعني الغموضَ بماهو استغلاقٌ نابِع عن خروج هذه اللغةِ عن المعاييرِ السائدة والأليفة في القولِ والتعبير، فارتباطُ الإشارة هنا بالغيبِ والباطنِ يجعلُها لا مرجعيةً وغامِضة. بهذا المعنى تكونُ اللغة الصوفية لغةً ليليّة.
2) لغة حيرى
تتحلَّى لغةُ الصوفيّ، بماهي جسدُ وجدِه، بالهيبةِ والبهاءِ، وذاك ما يميّز الليلَ. إنها تخترق الأُلْفَة، وتدفع بالحرفِ نحو أفقِ الغرابةِ والإدهاشِ بمقدارِ غرابة ودهشِ وخصوصيةِ التجربة التي تحياها روحُه؛ ذلك أن الصوفيّ يحاول أن يصِفَ ما لا يُوصفُ؛ أن يقولَ ما لا يَنْقَالُ؛ أن يكتُب ما لا يطيقُه قلَمٌ بشريّ. إنه يرقُمُ وجدَه على المَاء، يكتبُ بلغةٍ تفجّر فيضَ الوجدِ دون أن تقولَه. فما تستطيعُه هذه اللغةُ، ربما، هو إعلانُ صمتِها، هذا الصمتُ المثخن بالحيرة، صمتٌ تقوله لغةٌ مُبلَّلة بـ”ماءِ الغيب”، بجمالٍ شعريّ نكهتُه مُقدّسةٌ؛ لأنه يَنْطِفُ من رغبة في قولِ المُطلق بلغةٍ لها النسبيةُ والصيرورةُ هوية. فالصوفيّ يبغي قولَ الوحدانية بلغةِ التعدّد، الإفصاحَ عن الوترية بلغةِ الشفع، وإعلانَ الجمعِ بلغة الفَرْق. تلك حيرةُ اللغة الصوفيّة وسرُّ بهائها في آن، هذا البهاءُ الذي ينحفِرُ على جسدِ اللغة الصوفيّة كأوشامٍ شهيّة، وعن تلك الحيرةِ المقدّسة تنبثقُ الإشارةُ، تتدفَّق كلماتٌ مُبلَّلَةٌ بمدادِ المعرفةِ الإلهيةِ المُطلقة. على أن كيمياءَ حيرةِ الإشارةِ الصوفية هو ذاك التوتُّر بين المطلقِ والنسبيّ، فالإشارة هنا، عتبةٌ بين المقدّس والمدنّس، بين اللامحدودِ والمحدودِ، بين اللامرئي والمرئي، أو قل بلغةِ القوم إنها مجمَعُ بحري المعانِي والأوانِي، وهو المجمَعُ الذي يقعُ على خريطة الخيالِ بما هو برزخٌ بين عالمِ المعانِي وعالمِ الأجسام. هذه “البرزخية” هي التي جعلتِ اللغة الإشاريةَ تحتفي بالمجازِ، فمن خلاله تعلِن حيرتَها، ونشيدَ صمتها، وحلمَها المجيد؛ بعبارة إنها تفجّر من خلاله الرؤيا بماهيَ معرفةٌ نورانية. لنتذكر هنا أن تجلِّي أنوار المعرفةِ اللدنيّة، والذي تنحفرُ آثارُه بخشوعٍ وقشعريرةٍ على اللغة، يحصل في الليلِ كميقاتٍ رمزيّ للتجلي، للحلمِ المُقدس، للرؤيا. ربما كان هذا مصدرُ ليليةِ اللغة وغموضِها الإشاري، فـ “ليلى” التي طالما تغنّتْ بها القصائدُ الصوفية تشير إلى تجلِّي الذاتِ الإلهية في الليلِ بماهو “زمانُ الإسراءِ والمعراجِ والتنزلاتِ الإلهية”. هكذا يبدو مجازُ الليل نفسُه تمجيداً للمجازِ الذي تحتفي به اللغةُ الصوفية احتفاءَها بالخيال، ذاك ما تقود إليه حيرةُ الصوفيّ وهو يواجه اللغةَ، يخضِّبُها بالحيرة.
3) العالم مَجاز
تنخطِفُ يَدُ الصوفيّ برعشةِ السرّ الذي يلتهبُ في كنَفِه، واللغةُ هنا حيرةٌ لأنها وطنُ المسّ، لأنها فضاءُ المساررَةِ والمناجاة، والمُحب تسْتَرقُّه المواجيدُ فيهبَل ويخبَل بالمجاز؛ لأن المجاز “همسٌ”، أو قل كلامٌ ليليّ وليس تصريحا أو قولا شمسيا، كما أنّ المجاز، وبالأساسِ، لغةُ الكونِ التي يقرؤها الصوفيّ ببصيرته، بعينِ قلبه، بعينِه الثالثة. فالعالمُ مَجاز، ذاك ما يُقدسُه الصوفي في سِره، والكونُ بالنسبة إليه كتابُ رموزٍ، مُستودَعُ إشاراتٍ، مَسرحُ دلائل، مجلى آياتٍ، مرأى شواهدَ تشير جميعُها إلى الحقّ المحبوبِ بديعِ السماواتِ والأرض، إذ هو الظاهرُُ والباطنُ، الجليّ والخفيّ، المرئيّ واللامرئيّ، فهو لا مرئيٌّ بالوهْمِ، لكنه مُتحقِّقُ الوجود بالتحقيقِ في أنِيَّةِ الأشياءِ والأسماء؛ إذ هو عينُ كل أنيّة، وذاتُ كلّ هوية، وجوهرُ كلّ التعينات، وماهيةُ كلّ الموجودات، أما أشياءُ الكون ومحسوساتُه فأفياءٌ وألوانٌ، لا وجودَ لها من ذاتها، ولا تملِك في ذاتِها جوهر كينونتِها، إنها تفتقدُ لحقيقتها في نفسِها، لذلك فهي ظِلال، ووجودُها وجود مَجازِيّ. هكذا يغدو الكونُ كلّه صحيفةً منشورةً أمام الصوفيّ، يقرأ فيها بعينِ قلبه، دلالةً أحديّة، وأنيّة صمديّة، إليها يؤولُ كلُّ تعدّدٍ أو تكثُّرٍ أو شفْعِيّة. بهذا يمجِّدُ الصوفيّ المجازَ، ويؤثِر الصمتَ على الكلام؛ لأن الصّمت أبجديةُ الحبّ، وهو يرى في نفسَه كياناً مَجازيا لا وجودَ له إلا بوصفِه مُحِبًّا، وإذا ما “تكلَّم” كان المجازُ لغتَه كيما يُمجِّد صمتَه، صوناً لسرِّه عن غيرِ أهلِه، وصَدْعاً بأن لا كلامَ بعد كلامِ محبوبِه؛ فالمجازُ تشتيتٌ للمعنى عبرَ تكثيفِ الإيحاءِ والاحتمالات، بحيث يبدو المجازُ كلاما خامّا لم يُقَلْ بعدُ. إنه بحاجةٍ إلى “التعبِير” (بمعنيه: الإفصاح والتأويل). هكذا يحتفي الصوفيّ بالمجاز في “صمتهِ” و”كلامِه”.
4) تمجيد الهمسِ
الصمتُ من آدابِ الحضرة، تلك شعيرةٌ من شعائِرِ الحبّ لدى الصوفيّ، يمجِّدُها عبرَ المجاز؛ لأن المجازَ “هَمْسٌ”، وليس للمحبينَ سوى “الهمسِ” حين يسلُبهم بهاءُ كلامِ المحبوب، وتخشَعُ أصواتُهُم لهيبةِ رحمانيَّتِه، ولأجلِ ذاك الهمسِ المقدّسِ تُعانِق اللغةُ الصوفيّة الوحيَ كأصلٍ روحيّ باذخٍ، من خلاله تتبلّل اللغةُ بالشغفِ المطلقِ في قولِ قبساتِ الغيبِ التي يُكَاشَفُ بها قلبُ الصوفيّ. هذا اللقاءُ بين لغةِ الأرض وأسرارِ الغيْبِ هو ما تجسِّده، ببهاءٍ مطلَق، لغةُ الوحي. ذلك أن الألوهيةَ اتّصَلَت بالبَشَرِ من خلال الكلامِ، ولما تكلَّم الحقُّ صُعِقَ الخَلْقُ، فافتتنَ المحبّون باللغةِ، مُسُّوا بحيرةِ الحرفِ الذي حمَلَ السّر. لأجلِ هذا يحمِل الصوفيّ شهوةً مُزمِنةً للصمتِ وتمجيدِ “الهمْسِ” بدلَ الكلام، فالكلامُ الحقّ صدر عن الحقّ في فرادةٍ لا تتكرَّرُ، وكل أشكالِ الكلام بعده يجبُ أن تعتنقَ الصَّمتَ، أو تعلِن هذا الاعتناقَ حتى وهي تحاولُ الكلامَ (المجاز: الهمس). ذاك ما تجسدنُه الإشارةُ الصوفيّة، ذاك ما يبرِّرُها ويمنحُها نكهَتها الروحيةَ. إنها “همسٌ”، كلامٌ خامّ بقدر ما يُضمِر نيّةً في التكلّم، بقدر ما ينزع للصمتِ. من هنا يظهر أن الإشارةَ الصوفيةَ لا تحمِل في طيها “حقيقةً” معيّنة، أو قل هي “همسٌ” بـ”حقيقةٍ” مفتوحةٍ لا تكتمِلُ أبدا؛ حقيقةٍ يتخلّلها الصمتُ بكثافةٍ، وتُشيرُ إليها الدوالّ وقد تضمَّخَتْ بفيضِ الإيحاءِ، وتبلَّلتْ من بحرِ المعرفةِ التي تلوحُ على قلب الصوفيّ من غياهبِ الغيب. هكذا تكونُ اللغة هنا، بماهي همسُ العين الثالثة، سَفرا مفتوحا على قراءاتٍ لا متناهية، بحيث تُحلِّق الإشارةُ الصوفية عبر أزمنةٍ وأمكنةٍ مختلفة لتُحرّكَ قشعريراتٍ ما تفتأ تتجدّد، في قارئٍ ما يفتأ يتعدّد.
5) طاسين التلقي
وتثمُل لغةُ الصوفيّ بمجازاتِها القادمة نكهتُها من رحِمِ الأزل، تُقَطِّرُ الإشارةَ بأنوثةِ الهمسِ المجيد، ترتشفُ من هيبةِ الحيرة التي ترتجفُ منها أناملُ الصوفيّ. اللغةُ هنا بين الهيبةِ والبهاءِ تترنّح، بين القبضِ والبسطِ، بين الجلالِ والجمالِ، ذاك سرُّها العصيُّ على البوح، نسغُها الغريبُ عن غيرِ المكتوين بحيرةِ الحرفِ، إنها الحيرةُ التي تقودُ اللغةَ إلى “جنونِهَا”، إلى حتفِها حين تتجسدنُ، إذ تصيبُ الحروفُ بمسِّها جسدَ الصوفي، تبذرُ فيه دبيباً ناريا، يتخذُ أحوالا شتّى، تختلفُ بحسب وقتِ الصوفيّ ولحظاتِ سفره الروحيّ، فـيتمكّن أو يتلوّن، يتحرّك أو يسكُن، أو يجمع بين الضدين كالجبالِ {وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ(88)}. هنا تقولُ اللغةُ الصوفيةُ عبر الجسدِ ما لا يقولُه قولٌ أو يهمِس به حرفٌ، مقتبسةً ذلك من لغةِ الوحي المقدّسة، سلالتِها الروحية، ودوحةِ نسبها الباطني. فلغةُ الوحي تُرتَّل وتتجسدنُ بإطلاقيتها وتعاليها وتساميها وألوهيّتها في جسد المُصلِّي، حيث يُغذّي الجسدُ الإيمانَ مثلما يغذي الإيمانُ الجسدَ. كذلك اللغةُ الصوفية، وهي تحاكِي لغةَ التقديس، تمجِّد النغمَ و”السمَاع”، وتتجسدن في حضراتِ “الرقص”، إعلاناً عن فيضِ الوجد، وطمعاً في الزُّلْفى ومزيدٍ من الاكتواءِ بالحبّ والانمحاءِ في المحبوبِ، فتنتقلُ حيرةُ الحرفِ وحرقتُه من “همسِ” الإشارةِ إلى جذْبِ “العِمَارَة” (حلقةِ “الرقصِ” الصوفي). فالحركةُ هنا نداءٌ على السكونِ، أي سكونِ المحبِّ إلى محبوبِه في إطلاقيةٍ ووتريَّةٍ. هكذا تعانِقُ اللغةُ الصوفية، في شرائطَ تداوليةٍ روحانية، “الموسيقَى والرقصَ”، بوصفهما نمطاً من أنماطِ التجسيد و”التلقي” الصوفيّ، عناقٌ نكتشفُ من خلاله أننا إزاء لغةٍ سرّية تحتفي بطاسينِها، وتعلّم القارئَ أن يمجِّدَ التواضعَ وهو يقترب منها. ذلك أن هاته اللغةَ تُمرِّنُ قارئهَا على عشقِ الصمتِ، والانتشاءِ بالصدى؛ لأنها تحتفظ بسرّها وهيبتِها، أعني هيبةَ العشق التي لا تعادلُها هيبةٌ. إنها لغة تستدعي ذوقَ القارئ لـ”يَحْتسِيَ” معناها، فهي لا تكتفي بقولِه، بل إنها لا تقولُه، وإنما “تهمِس” به، تستشرفُه، تبذُرُه في مستقبَلِ قراءةٍ عاشقةٍ لها نكهة “الرقص”. بهذه التقاسيمِ تفتن اللغةُ الصوفيةُ ببهائِها قارئَها، وتحيّر مريدَها، وتزدانُ، على إيقاع الوجدِ، حين تُنشَدُ وإن لم تُفْهَم…
محمد التهامي الحراق