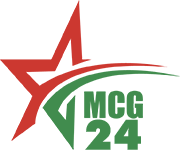إن الطبيعة الاجتماعية للإنسان تفرض عليه العيش وسط الجماعة ومخالطة العوام والخواص، يقول ابن خلدون في مقدمته: “إن الإنسان اجتماعي بطبعه” وهذا يعني أن الإنسان فطر على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين ، وحتى كلمة إنسان أتت من الأنس ، فهو يستأنس بمن حوله …
في سبيل ذلك يستجيب الفرد لطبيعته نحو التطور والرقي في سلم الحاجات إلى أن ينتهي أمده، وقد أبرز العالم “أبراهام واسلو” تدرج هذه الحاجات حسب أهميتها في شكل هرمي ، وتتجلى في الاحتياجات الفسيولوجية ، واحتياجات الأمان ، بالإضافة للاحتياجات الاجتماعية والحاجة للتقدير ولتحقيق الذات.
إلا أن الوعي بها غير متاح للجميع، فقد يعي البعض وجود هذه الاحتياجات ويسعى لتحقيقها، وقد يجهلها البعض الآخر ويتركها للصدفة، فالوعي بالأمور جزء من فك ماهيتها ونيل ثمرتها.
لطالما كان الإنسان باحثا عن الحقيقة في نفسه وغيره ،ومنقبا عن حقيقة الوجود والغاية منه ، وماهية الكون و مرتكزاته ومآله ، و عن الخالق لما نحن فيه مستندا على ملكة السؤال والتدبر.
هذا البحث عن التموقع داخل الكون هو ما يميز الإنسان بإنسانيته عن باقي الموجودات ، ولعل تعطيل الفكر والبحث هو ما يعطل اكتشاف الإنسان لقدرته .
بالتساؤل والتدبر نكتشف أننا متفردون، لا يشبه أحدنا الآخر ولو صعب علينا رصد الفارق ، فقط يظل أن نفكر ونستجيب لفطرة السؤال ، لكن حينما عطلنا فينا هذه الفطرة وخمل فينا التدبر وأحلنا مصيرنا لغيرنا، التبست الأمور علينا و لم نعد نفكر بمنظورنا الخاص ، فأصبحنا نقاد كالقطعان ونجر جرا وطمس فينا التفكير .
هنا أصبحنا زمرا متفرقة ، زمرة مقادة وأخرى قائدة بما لها من تفوق افتراضي على الآخرين ، وبما تنازلت عنه الطائفة الأولى من حمل التفكير، كأنه تفويض باستخدام العقل أو توكيل غير مشروط ، فالتسليم يفيد الرضوخ لحكم الغير ولو جار بفكره مادام التفويض غير مؤطر ومسيج بضوابط جامعة .
تطورت الفرقة وبرزت الطوائف والشروخ بين الناس، وصار يقال هذا من العوام وذاك من الخواص، وآخر تابع وذاك متبوع، فالتبس الغي بالمنطق واستشكل، وضاعت المعاني والمعايير وسط أنانية الفرد وغياب الإيثار.
فبرز ما يسمى بالطائفة “المثقفة” ، مع العلم أن لي في هذا قول: ذلك أنه من الصعب القول بتعريف جامع ومانع متفق عليه لمفهوم “المثقف” ، حيث استعصى الأمر بين المثقفين أنفسهم وامتنع عنهم تعريف دواتهم وأدوارهم ، وامتنع ذلك بين المفكرين والفلاسفة وأهل اللغة والعرب والمستشرقون ، والحداثيون والأصوليون…
وأجل مثال على ذلك ما قاله “رايموند ويليامز” صاحب الكلمات المفاتيح ،حيث قال :”لا أدري كم مرة تمنيت ألا أكون قد صاد فت هذه الكلمة اللعينة في حياتي ” ، وأردف قائلا : “إن كلمة ثقافة من بين الكلمات الأكثر تعقيدا والتي يصعب تعريفها “.
على أنّ “تايلور “عرف الثقافة في كتابه “الثقافة البدائيّة” بكونها : “الكُل المُركب الذي يشمل المعرفة، والعقائد، والفنّ، والأخلاق، والقانون، والعُرف، وكلّ القدرات، والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضواً في مجتمع”.
وهنا نتسائل هل كل ما ذكر مشترك بيننا ولا نقاش فيه ؟ هل مفهومنا للمعرفة و للأخلاق والفن والعقيدة واحد؟
هذه المفاهيم المتوسع فيها والمتصارع على ضبطها تنتج اليوم التباسا حقيقيا ، حيث التبس علينا التمييز بين الثقافة ونقيضها وجوهر الأخلاق ونطاق الفن ومداه وما يعد فنا و ما لايعد.
فالخطورة تكمن أن بعض المنتسبين لأهل الثقافة إن افترضنا وجودهم ، يسمحون لأنفسهم بوضع التعريفات والحدود بين هذا وذاك ،وإقصاء الطائفة التي تحدثنا عنها آنفا لكونها مجرد متلقية ومستهلكة لنتاج المثقف.
لكن يمكن القول أنه : بما أن مفهوم المثقف غير متفق عليه ، فكلنا مثقفون إذا !
قال الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي في هذا المنحى : ” بإمكان المرء القول إن كل الناس مثقفون ، لكن ليس لهم كلهم أن يؤدوا وظيفة المثقفين في المجتمع ”
فمن هذا المنطلق يحق لنا التساؤل كذلك هل المثقفون فئة كبيرة من الناس أم نخبة رفيعة المستوى وضئيلة العدد؟
فقد اختلطت الأمور ببعض على الناس وتاهت العامة عن المثقف كي تهتدي بقوله وترجح الصواب والخطاء بأفكاره ، أهو ذلك الكاتب الذي يعالج قضايا الأزمنة الغابرة ويمجد الأيام الخوالي ويتحسر على الأندلس ، أم أنه المتمرد بفكره على كل صغيرة وكبيرة ، أم ذلك المغني أو الراقص، أو من اطلع على ما تيسر له من الكتب ، أم ذلك الواقف على الربائد المتعالي بفكره ، أم ذاك الفقيه بمجاله ، أم كل ذلك أو دون ما سبق ؟
تساؤلات عديدة لا إجابة قطعية لها في ظل الصراع من أجل ضبط المفهوم ، ونمثل لذلك برأي جوليان بندا الذي اعتبر أن : ” المثقفين الحقيقيين هم اللذين لا يهدف نشاطهم أساسا إلى تحقيق أغراض عملية، وكل اللذين ينشدون السعادة في ممارسة فن ما أو علم ما ، أو في تأملات ميتافيزيقية ، أي باختصار في التحلي بمزايا غير مادية ، وهم من يقولون بطريقة ما : مملكتي ليست من هذا العالم”.
إلا أن هذا الرأي غير سليم، فلا غاية ترجى من المثقفين المنفصلين عن العالم الواقعي، والمنصرفين إلى الاهتمامات الخيالية والمقيمين في الأبراج العالية الذين يعالجون المواضيع المبهمة.
فالمثقف الحقيقي هو الذي يتفاعل مع الواقع ويناصر العدل وينشد الفضيلة ،ويشجب الفساد ويعارض القمع، لربما باختصار ،المثقف هو من استطاع عقله مراقبة نفسه على حد قول “ألبير كامو”
إننا أمام مفهوم خطير لا يستهان بقدره ولا يؤتمن صاحبه ،فضبط المفهوم سيضع أمامنا آلية لتعيير المنتسب لهذه الطائفة من عدمها ، ويحدد لكل اختصاصه وحدود تدخله ، وسيحدد للناس الأجدر بالإتباع والأولى بالترك .
لكن لم نعطل آلية التفكير فينا ونكتفي بالإصغاء ؟ ولم نؤله البشر ونقدس الأشخاص ؟
عد لفطرة السؤال والتدبر ، قال سبينوزا في هذا الصدد إن أعلى نشاط يمكن للإنسان تحقيقه هو تعلم الفهم ، لأن الفهم يعني أن تكون حرا.
فكن مع الفكر الحر الناقد المستقل عن سلطة الجبر .
محمد الغالمي
مدون مغربي