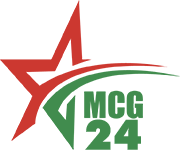في التباسات قراءة القرآن الكريم: ومضاتٌ نقدية – الومضة الثالثة والأخيرة
محمد التهامي الحراق
الومضة الثالثة: عبد الجواد ياسين والتباس “الدين والتدين” في النص
في لقاء مفتوح مع المفكر المصري عبد الجواد ياسين بتاريخ 12/01/2019 بمؤسسة “مؤمنون بلا حدود”، وتعيينا بصالون جدل بالرباط، أثارني جوابُ الأستاذ ياسين على سؤال طرحه أحد الحاضرين عن آيات الأحكام في القرآن الكريم، والتي يعتبرُها من معالم التدين في النص القرآني لا الدين؛ حيث ذهب عبد الجواد ياسين إلى إسقاط كل تعالٍ عن هذه الآيات، وهو في نظرنا ما يتوافق، بشكل من الأشكال، مع الداعين جهارا إلى إسقاط أو حذفِ الآيات التاريخية من النص القرآني، أي تلك الآيات ذات الصلة الوثيقة بأحداث ووقائع مخصوصة في زمن التنزيل وسياقه الاجتماعي والتاريخي والأنتروبولوجي.
ولنا على هذا الفهم الملتبِسِ اعتراضاتٌ من بينها:
- بغض النظر عن الاختلاف الذي قد يلحق التمييز بين آيات الدين وآيات التدين في النص القرآني؛ أي آيات القيم المتعالية والروحية والأخلاقية الكلية العابرة للأزمنة والأمكنة وآيات التقنينات والأحكام المرتبطة بطبيعة الإشكالات المطروحة على الرسول r زمن التنزيل وفي سياقه التاريخي والاجتماعي والثقافي المخصوص، فإن ثمة إغضاءً عن البعد المتعالي في آيات الأحكامِ نفسِها، والذي تستمده من “الوحدة البنائية العضوية للنص القرآني”، والضامِرة في مَنْشُودِ قراءةِ لا نسقية النصّ الظاهرةّ ذلك أن آيات الأحكام تتجاور وتتحاور وتتآثر وتتبادل التحديد مع آيات أخرى في نسيج قرآني يعيد بناء دلالية النص في أفق روحاني وشعائري ينطلق من التاريخ لينفصل عنه؛ وهو الأمر الذي يُسعف فيه الترتيبُ “التوقيفي” للآيات الذي لا يلتزم بالشروط التاريخية، وبذلك يشيد النصّ أفقا دلاليا متعاليا لا يتقيد بالتاريخ وتصير فيه للّغة كينونةٌ روحية تلبّي أشواقا وتنسج بواطن وتستجلب طاقة جوانية تنتظم في إدراك إيماني يتعذر وصفُه بالأدوات المفاهيمية التاريخية أو الوضعانية. هذا الإدراك الإيماني هو الذي يدعمه التجاورُ والتوالج البنيويان بين الآيات في النص كيفما كانت طبيعتها “الدينية”او “التدينية”، مثلما تدعمه التلاوة الشعائرية لتلك الآيات في الصلاة والتنسك والتعبد.
- إلى جانب هذا التعالي الذي تستمدُّه الآيات “التدينية” من داخل النص، ومن تلقيه الشعائِري والروحاني، ثمة أفق آخر في تلقي النص القرآني يُلغي ذاك النزوع إلى إلغاء التعالى وإسقاطه عن تلك الآيات، وهو تلقيها الإشاري العرفاني في التفاسير الصوفية للقرآن الكريم، بحيث يتم تأشير (من الإشارة الصوفية) تلك الآيات، وفتح دلالاتها على آفاق إدراكية روحية تنسجم مع كليات النص الروحية والأخلاقية، وتضمن لها الاستمرار في “التدليل” وإنتاج المعنى خارج سياقاتها التاريخية، وذلك بما يلائم بنيةَ النص وتلقيه الشعائري والروحاني. وهو أفق ظل منسيا في قراءة المفكر عبد الجواد ياسين، ومن يسير في اتجاهه.
ج-الأمر الثالث، أنه يمكن، وخارج التلقي التعبدي او الإشاري للنص، قراءةُ تلك الآيات “التدينية” قراءةً تاريخية تأويلية لا تاريخوية وضعانية؛ بمعنى أن لا نُقصيها ونسقطها بذريعة ارتباطها بسياق تاريخي انتهى وانقضى وتلاشت معطياتُه ومحدداته؛ بل أن نميز فيها بين المفهوم والمِصداق، أو قل بين “الموقف” و”المضمون” إذا استعرنا لغة المفكر المغربي عبد الله العروي[16]. فقد يكون المضمون تاريخيا، لكن الموقف، أي منطق التعامل مع الحدث في السياق المخصوص، هو المشمول بالتعالي. وهو أفق مفتوح للاستنباط وتجديد القراءة والتأويل متى ما توافر شرطا الاجتهاد العقلي والمجاهدة الروحية، وهما شرطان متضافران لا ينفصلان في القراءة العقلانية الإيمانية المستجيبة لخصائص العقلانية القرآنية. ولعل هذا هو الأفق الذي يجب فيه تجديد فهم القاعدة الأصولية التي تقول بـ”الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”؛ إذ ربما وجب الأخذ بمنطق الحُكم وفلسفته الأخلاقية والروحية الكامنة فيه، لا الأخذ بمنطوق الحكم الذي تغيرت شرائطُه التاريخية. وهنا يبدو وكأنّ الحكمَ الوارد في الآيات التدينية في ذاته ذو وظيفة بيداغوجية لاستبطان الموقف والمنطق لا المضمون والمنطوق في حرفيته. هكذا نخلص إلى أن ثمة أبعادا تدعونا إلى رفض المزالق التي يقودنا إليها توجه الأستاذ عبد الجواد ياسين الذي شرحه في كتابه “الدين والتدين” وأكده في لقاء “مؤمنون بلا حدود” المشار إليه، وسار فيه غيره إلى حد الدعوة إلى حذف آيات من القرآن الكريم. وهي دعوة، كما يبدو، داحضة متهافتة، لكونها لا تنتبه إلى مطب التجزيئية التي تقع فيها حين تفكّك أوصال النص وتشظّيه؛ فيما هي تسيء قراءةَ بنيتِه واستيعابَ إمكاناتِ الوحدة العضوية الضامرةِ في ظاهرِ لا نسقيته؛ وهو ما لا يؤهِّلُ هذه الدعوةَ، في نظرنا، لتكونَ مدخلا للإصلاح أو التجديد أو التنوير في التعامل مع النص القرآني في السياق الراهن.
وخلاصة القول، إن التعامل مع النص القرآني يقتضي الالتفات إلى خصائصهِ البنيوية، لغةً و”نغمةً” وأفقا؛ مثلما يقتضي الالتزامَ بشروط ميثاقِ القراءة التدبرية، والواردةِ معالمُها في النص نفسِه؛ والتي بموجبها يتم تبديد جملة من التباسات قراءته؛ حيثُ ندركُ ، من بين ما ندرك، أن اللانسقيةَ هي علامةٌ من علامات العقلانية القرآنية، وأن تلك اللانسقيةَ تُضمِرُ وحدةً عضوية ما تفتأ تتناسل في منشود القراءاتِ، وأنها تجعل النص مفتوحا لا يقبلُ إغلاقَهُ بالمماهاةِ بينه وبين قراءةٍ من قراءاتهِ؛ مثلما لا يقبل تجْزِيئهُ أو ابتسارَهِ بمبضعِ ثنائيات حديةٍ يتعذر عليها استيعابُ الديناميةِ الروحانية والمعرفية للنص، كما هو شأن ثنائية الدين والتدين، أو ثنائية التعالي والتاريخ.
===========
[1] – العروي، عبد الله، “السنة والإصلاح“، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،2008 ، ص.74.
[2] – راجع: أركون، محمد، “قراءات في القرآن“، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، 2017، ص.82.
[3] – Bidar, Abdennour ; «Un islam pour notre temps» ; Seuil, 2017 ; p.98-99.
[4] – راجع : الحراق، محمد التهامي، “في الجمالية العرفانية..من أجل أفق إنسي روحاني في الإسلام“، دار أبي رقراق، الرباط، 2020، ص. 36-37.
[5] – بنعبد العالي، عبد السلام، “جرح الكائن“، دار توبقال، الدار البيضاء، 2017، ص.125- 129.
[6] – راجع، مثلا، كتاب إيان ألموند، “التصوف والتفكيك – درس مقارن بين ابن عربي ودريدا”، ترجمة حسام نايل، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2011، أو كتاب خالد بلقاسم، “الكتابة والتصوف عند ابن عربي“، دار توبقال، الدار البيضاء، 2004… إلخ.
[7] – نشرت أعمال هذه الندوة ضمن كتاب: “ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة“، تنسيق محمد المصباحي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2003.
[8] – المصباحي، محمد، “نعم ولا، ابن عربي. والفكر المنفتح“، منشورات ما بعد الحداثة، فاس 2006، ص.53-60.
[9] – المسكيني، فتحي، “الإيمان الحر أو ما بعد الملة…مباحث في فلسفة الدين“، مؤمنون بلا حدود، بيروت- الرباط، 2018.
[10] – القباجي، أحمد، “سر الإعجاز القرآني..قراءة نقدية للموروث الديني في دائرة الحقيقة القرآنية وتأصيل الإعجاز الوجداني“، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2009، ص.126.
[11] – العروي، عبد الله، “السنة والإصلاح“، المركز الثقافي العربي، الدر البيضاء، 2008، ص.78.
[12] – راجع: “الحلاج شهيد النغم”، ضمن كتابنا: “مباسطات في الفكر والذكر“، دار أبي رقراق، الرباط، 2019.
[13] – مجلة “يتفكرون“، العدد 11/2018.
[14] – نفسه، ص.152.
[15] – “قراءات في القرآن”، م.س، ص.82.
[16] – العروي، عبد الله، “نقد المفاهيم“، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء 2018، ص. 114.