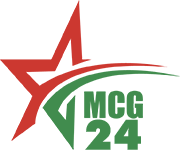الدرس الثاني من دروس صفات عباد الرحمن :قال جل شأنه: {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا}
عبد الرحمان سورسي
أحمدُ الله حق حمده، له الحمدُ في الأولى والآخرة وله الحكمُ وإليه ترجعون، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأنَّ مُحمدًا عبدُهُ ورسوله، صلى اللهُ عليه وعلى آله وصحبه ومنِ اتبعَ سنته واقتفى أثره بإحسانٍ إلى يومِ الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ عباد الرحمن جمعوا كمالَ الخصال، جمعوا طيب الفِعال، جمعوا مكارم الأخلاق، إنهم أصحابُ برٍّ وخيرٍ وفضلٍ في معاملة الله عز وجل، وفي معاملة الخلق؛ لذلك ذكرَ الله جلَّ وعلا في صفاتهم ما يُبيِّنُ كمالَ خصالهم في علاقتهم بالله عز وجل، وفي صلتهم بالخلق فليسَ ثمةَ انفصالٍ، ولا انفصام بينَ الخُلُق الذي يتعاملُ بهِ المؤمن مع الخلق والخُلُق الذي يتعامل بهِ مع الخالق، فإنَّ ثمةَ ارتباطًا وثيقًا بينَ طيب الخصالِ في صلة العبد بربّه، وطيب الخصالِ في صلة العبد بالخلق؛ ولهذا يقولُ النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءَ في مسند الإمام أحمد بإسنادٍ جيد: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَصَالِحَ الْأَخْلَاقِ»، والأخلاق هُنا بمفهومها العام الشامل الذي ينظم كُلَّ خصلةٍ كريمة، وكُلَّ خُلُقٍ فاضل، وكُلَّ سجيَّة صالحة، سواءً كانت في معاملة العبد لربِّه، أو في معاملة العبد للخلق؛ ولذا لا تعجب أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل دعوته، كان يأمرُ بصلة الأرحام، وبإغاثة الملهوف والعفاف، وغيرِ ذلكَ من الخصال الكريمة التي تضم صلاح ما بينَ الإنسانِ وغيره، وإنَّ صلة الإنسان بالناس لا بدَّ وأن يعتريها ما يُكدِّرُها، فالناس مجبولون على أنواع من الخصال التي تحملُهم على الاعتداء، تحملُهم على التقصير، تحملُهم على الظلم، ومقابلة هذه الخصال بأمثالها، قد يفضي إلى ما يكونُ سببًا للشرِّ بينَ الناس، فلهذا نُدِبَ المؤمنون وعبادُ الرحمن إلى الكمال في معاملة الخلق، بفعلِ ما تقتضيهِ المصلحة من العفو والصفحِ، والإعراضِ عن أهل الجهل والخطأ؛ قال اللهُ جلّ وعلا: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} ، وهذا يُبيِّن أنَّ العفو المأمور به، إنما هو مقيَّدٌ بالإصلاح، فإذا كانَ العفو يُفضي إلى الاستطالة، يُفضي إلى الفساد، يُفضي إلى تضييعِ الخير، وتكثير الشر، فعندَ ذلكَ لا يكونُ العفو مأمورًا به، إنما يأمرُ بالعفو إذا كان صلاحًا.
من خصال أهل الإيمان وعباد الرحمن التي ذكرها اللهُ تعالى في مُحكَم الكتاب، ما ذكرهُ في آيات سورة الفرقان، في قوله: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} ، قال: {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} أي: إذا تكلَّم معهم أهل الجهل، والجهل يحملُ على عدمِ الإحسان في القول، وعدم الإحسانِ في العمل، وإنما ذكرَ جلَّ في علاه الخطاب في هذه الآية، لأنَّ الخطاب أهون ما يصل للإنسان من الإساءة، وإلا فقد يصل إليه إساءة فعليَّة، فيكون الإنسان إذا قابلَ القولَ بالسلام، فإنَّ ذلك يحمِلُه على الكف عن مقابلة الإساءة بمثلها، بل الله عز وجل، أمرَ العبدَ، أن يدفع بالتي هي أحسن، وأن يدرأ بالتي هيَ أحسن، كما قال اللهُ تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} وهذا يدل على أنَّ الدفع بالتي هي أحسن، سواء كانَ قولًا، أو كانَ عملًا، أو كانَ فعلًا، هو مما يحصلُ بهِ الخير للإنسان، ويدفعُ بهِ عنهُ إساءةٌ، ويدفعُ بهِ عنهُ شرٌّ لا يَرد على خاطره في كثير من الأحيان، اللهُ جلّ وعلا يقول:{وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} فمن الجاهلون؟
الجاهلون هم صنفان من الناس: الصنف الأول: هم الذين لا يعلمون، فتصدرُ عنهم أفعالُ جهل عن غير علمٍ ولا وعي ولا إدراكٍ ولا بصيرة، وهذا حال كثير من الناس، في معاملتهم للخلق يجهلون، ويقعون في الخطأ، لكن ثَمَّةَ نوعٌ من الجهل، وهو الخطأ المتعمَّد، وهو فعلُ ما يريدُ بهِ الفاعل الإساءة، مع علمهِ بأنَّ ذلك إساءة، وخطأ، وهُنا يكونُ هذا أعلى ظُلمًا وأكبرُ خطأً وجُرمًا من ذاكَ الذي وقع في الخطأ عن غيرِ علم، أو وقع في الجهل عن غيرِ معرفة، فإنَّ ذاكَ أدنى منهُ منزلة في كلا الحالين.
نَدب اللهُ تعالى أهل الإيمان، وذكر من خصال عباد الرحمن، أنهم يُقابلون الإساءة بالإحسان، ولذلكَ قال جلّ في علاه:{وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} ، قوله جلّ وعلا: {قَالُوا سَلَامًا} ليسَ المقصود بهِ هذهِ الكلمة بعينِها، بل المقصود أنهُ لا يكونُ منهم قولٌ يحصلُ بهِ إلا السلامة لمن يسمعه، والسلامة تتضمن كف الأذى، عدم مقابلة الإساءة بمثلها، بل تقتضي أن يحلُم الإنسان عمّن جَهِلَ عليه، ويكُفُّ غضَبَهُ، ولا يستجيب لتلك الاستفزازات، التي صدرت من الجاهل في معاملته، فحملتهُ على أن يتكلَّم بالكلام السيء، فلا يُقابل المؤمن تلكَ الإساءة بمثلها، هذه مرتبة علو وفضل، ومنزلة سمو وارتفاع، لكن أذِنَ الله جلَّ وعلا لأهل الإيمان أن يُعاقبوا مَن أساء إليهم بمثلِ ما صدرَ منهم، ولذلك قال: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} ، {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} ما لم تكن محرمةً في ذاتها، فإذا سبَّ الإنسان سبّةً تتعلّق بوصفٍ لهُ بالقبيح، وليسَ فيها تحريم كلعن الوالدين مثلًا، أو القذف، وما أشبه ذلكَ من الألفاظ والأمور المحرّمة لذاتها، فإنهُ لا بأس أن يُقابل الإساءة بالإساءة، وهذا نوعٌ من السلام؛ لأنهُ لم يتجاوز، لكن كمالُ السلام هو أن يحلم؛ ليدخل في عموم قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾
أيها السادة والسيدات: إن القرآن الكريم يعالِجُ مشكلةَ الجهل والجاهلين في مواضعَ كثيرة، وقضيةُ الجهل من القضايا المهمة التي تناوَلَها القرآن الكريم، واضعًا الحلولَ والمعالجات المهمة لها.
فعن الحسن في ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ [الفرقان: 63]، قال: حلماء، وإن جُهل عليهم، لم يجهلوا.
وقوله: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ [الفرقان: 63]، يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون باللهِ بما يكرهونه من القول، أجابوهم بالمعروف من القول، والسدادِ من الخطاب.
وعن الحسن في قوله: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ [الفرقان: 63]، قال: إن المؤمنين قوم ذُلُلٌ، ذلت منهم واللهِ الأسماعُ والأبصار والجوارح، حتى يحسبهم الجاهلُ مرْضى، وإنهم لأصحَّاء القلوب، ولكن دخَلهم من الخوف ما لم يدخل غيرَهم، ومنعهم من الدنيا علمُهم بالآخرة، فقالوا: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ [فاطر: 34]،
وختاما أيها الإخوة والأخوات: فإن هذا الحل الذي يقدِّمه القرآن الكريم عند التعرُّض لأي موقفٍ من جاهل، حلٌّ يسير وعملي، وقابلٌ للتطبيق في أي زمان ومكان، إنه حل: ﴿ قَالُوا سَلَامًا ﴾ [الفرقان: 63]، بهذه الكلمة فقط، وما أيسَرَها، وأسهَلَها، وأوضَحَها! تواجه موقف الجهل من أي جاهل، فبدلًا من أن تقضي الوقت في التخاصم والمنازعة، يعلِّمك القرآن الكريم أن تواجه الجاهلَ بكلمة: ﴿ قَالُوا سَلَامًا ﴾ [الفرقان: 63]، وما يلزم منها من سكينة وحلم ووقار، والمعروف من القول، والسداد من التخاطب.
وتبارك الله ربُّنا أحسن القائلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.