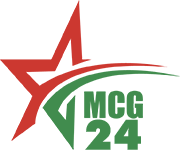في التباسات قراءة القرآن الكريم: ومضاتٌ نقدية – الومضة الأولى
محمد التهامي الحراق
الومضة الأولى: التباسُ اللانسقية والقراءةُ المفتوحة
ربما كان من بين خصوصية الفعل العقلي القرآني، أو لنقل بنوع من التجوز “البنية القرآنية” التي يمكن تعقُّلها، أنها بنية قائمة على ما سماهُ الشيخ الأكبر في توصيفِ كتاباته بـ”التبديد”؛ ويسميه البعض اليوم بـ”اللانسقية”. فمع النص القرآني نحن لسنا إزاء “نص” نسقي مغلَق، له بداية ووسط ونهاية؛ أو استهلال وعقدة وحل؛ أو أطروحة ونقيضها ثم تركيب، أو مقدمات وتحليل واستخلاصات؛ نحن لسنا إزاء مقدمات منطقية وبناء استدلالي متماسك يفضي إلى نتائج محددة. هذا العقل المُنَظَّم و”المنطقي”، قد يُعيد بناء المادة القرآنية وفق “بنيته المنطقية”؛ لكن لا يستنفد الآفاق والمسارات والمسالك والقراءات الممكنة للنص القرآني، بحُكم ما يطبع النص من “قفز” و”تنوع” و”تناثر”[1]، أو قل بحكم “بنيته اللانسقية”. ولذا، حين يقرأ كثير من الغربيين اليوم القرآن الكريم مترجَما، يجدون عنتا في التواصل معه[2]؛ لأنه يقع خارج مألوفِ تقاليد الفهم في تعقلاتهم وقراءاتهم، ومن ثم يكونون دوما في حاجة إلى ترجمات تفسيرية تعيد “بناء” المعاني بشكل يحقق “استيعاب” القرآن الكريم في معقولية القراءة وتقاليدها النسقية.
إن هذا الميسم اللانسقي يترجم طبيعة “العقلانية القرآنية”، بما هي فعل عقلي دينامي يشتغل بآليات “التذكر” و”التدبر” و”التفكر” و”الإبصار” … من أجل تغذية القلب بالمعنى وتخصيبه بالإيمان. إنها عقلانية تنكتب في أسلوب من علاماته “التشذير” و”القفز” في المواضيع، و”التنويع” في الأساليب، والمزج بين الأمكنة والأزمنة، والجمع بين آفاق وسياقات ضمن مجاورات تحتفظ بسرية علائقها الدلالية التي تشكِّل موضوع استكشاف لا نهائي. إن هذه العقلانية القرآنيةَ أشبه ما تكون بـ “عقلانية” الوحي المنظورةِ آياتُه في الكون؛ فثمة دوما تناغُم وتناسق وانسجام بين مختلِف مكونات هذا الكون، لكنها تحتفظ بلغزها الذي على العلم أن لا يكفَّ عن السعي لحلّه واكتشاف ما ينتظمها من نواميس وسنن، ويشج بينها من علائق. ذاك أيضا ما يحتاجهُ الوحي المسطورةُ آياتُه في المصحف الكريم؛ فالعقلانية القرآنية ثابتة في الانسجام الداخلي للنص، والذي على القارئ دوما أن يكتشفه؛ إذ ثمة وعدٌ إلهي أن هذا الوحي المسطور لا تنافر ولا انفكاك ولا تفكك في “بنيته العميقة”، أو قل باللغة القرآنية لا “اختلاف” ينخرُ هذه البنية الكائنة معالمُها اللانهائية في كل قراءة تدبرية سليمة؛ قال تعالى: “أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا” (النساء، الآية 82). وكل انسجانٍ بـظاهرِ “لانسقية” النصّ، هو إخلاف لميثاقِ قراءته، الذي ينهى عن تجزيئه وتعضيته، قال تعالى: “وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ المُبِـينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِـينَ الَّذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِينَ” (الحجر، الآية 91).
على أن من خصائص هذه العقلانية القرآنية الواشجة بين القلب والعقل، بين الاطمئنان والتساؤل، أن البنية التبديدية للنص القرآني وخصيصته اللانسقية، بقدر ما يتم ترميمها وتجبير شقوقها عبر التلاوة الشعائرية، والتلقي الإيماني الروحاني، بحيث تشكل هذه الخصيصة أداةً لطيفة للسفر إلى عوالم الغيب، والمعاني المتعالية والآفاق الخشوعية التي تذاق ولا تنقال، إذا استعلمنا لغة الصوفية؛ أقول بقدر ما يتم ذاك الترميم والتجبير والتلقي بقدر ما تجعل هذه الخصيصةُ ذاتُها من “عقلانية” النص القرآني أفقا كونيا منفتحا على إعادة القراءة وإعادة البنينة وإعادة التشكيل “النسقي” وفق المعقوليات المتجددة للقراء المتجددين عبر تعاقب الأحقاب وتوالي الأزمنة وتغير العصور المعرفية. وهو ما يعني أن خصيصة “اللانسقية” واحدةٌ من معالم انفتاح النص القرآني على تعدد إمكانات البنينة والصياغة النسقية، بحيث تتحقق هذه البنينة وهذه الصياغة بما يلائم المعقوليات المتجددة والصائرة والمتحولة حسب الأزمنة المعرفية المتغايرة. وهذه واحدة من علامات خلود النص القرآني وتعاليه؛ إذ النصُّ النسقي المغلَق مهدَّدٌ بالتاريخية، فيما النص اللانسقي المفتوح يملك قدرة على محاورة المخاطَبين المختلفين تاريخيا، ومن ثم تصبح هذه الخصيصة علامة من علامات تعالي النص على مستوى الأسلوب، وضمانة من ضمانات مخاطَبةِ النصِّ للناسِ كافة في مختلِف الأزمنة والأمكنة، وبتغاير إبستميات القراءة ومنطلقات استنطاقها. بهذه المثابة، لا يفتر الوحي عن التنزل على عقول وقلوب المخاطَبين، ولا يكف الله سبحانه عن مخاطبة الإنسان بالوحي الدائم؛ لدرجة يمكن معها القول: إذا كان للنص القرآني من معالم “إعجازية” خالدة، فهذه واحدة من أبرزها؛ أن يكون متعاليا ومطلقا في التاريخ المتغير والنسبي؛ وذلك عن طريق الانفتاح الدائم على إعادة الصياغة النسقية المتجددة، ومن ثم إعادة القراءة، حسب أسئلة وانشغالات وأدوات ومحددات كل عصر من العصور المعرفية المتناسخة.
في هذا السياق، أستحضرُ، على سبيل التمثيل، نموذج “القراءة” التي قدمها عبد النور بيدار في كتابه “من أجل إسلام يليق بزماننا“[3]؛ حيث ذهب إلى أن تلك اللانسقية في النص القرآني هي المعادل الموضوعي اليوم للكاووس الذي يخترق المجتمعات الغربية الما بعد حداثية، حيث تشكل تلك الخصيصة أمراً ملهِما للمعنى في سياق تبديد المعنى المميِّز لزمن ما بعد الحداثة. ولعل هذه الخصيصة هي التي تجعل اليوم القراءة العرفانية الأكبرية المنفتحة والمنشرحة للنص القرآني[4]، والمبثوثة في كتابة تبديدية منسجمة مع لا نسقيةِ الوحي المجموع في مدونة مكتوبة؛ تجعل تلك القراءة متوافقة مع الأفق الما بعد الحداثي الذي يحتفي بالكتابة الشذرية التي تشذِّر الزمان، وتجعله لا خطيا بل زمانا دائريا، وتنفر من الخطية والاتجاهية الأحادية إلى نوع من “العود الأبدي” بالمعنى الفلسفي المعاصر. ها هنا تأتي قراءةُ “دائريةِ” فكر ابن العربي وكتابته الارتحالية وطبيعتها التدفقية التناقضية في ضوء النص النيتشوي[5]؛ بل والذهاب إلى إيجاد تقاطعات بين ابن العربي و جاك دريدا[6]، وكذا تنظيم ندوة دولية في الرباط خلال بداية الألفية الثالثة بعنوان مثير: “ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة“[7] ، وإصدار محمد المصباحي كتابا بهذا النزوع تحت عنوان: ” نعم ولا، ابن عربي، والفكر المنفتح ؟”[8].
كما نسجّل هذا النزوعَ أيضا في كتاب مثير ومنزاح عن مألوف الكلام في فلسفة الدين في العالم العربي، أعني كتاب “الإيمان والحر أو ما بعد الملة” لفتحي المسكيني[9]، وهو يذهب إلى أن الإيمان الملِّي النسقي المُغلَق قد استنفد دوره، وأنه أصبح يتعلق بإلهٍ لم يَعُد حيا في قلوب وحيوات المؤمنين إلا على سبيل التذكر والعادة؛ وأن أفقا لإعادة ترتيب العلاقة الإيمانية بأنفسِنا يتشكل خارج الملة؛ أفقا بقدر ما يُحْرِج الإيمان الملِّي يحرج، حسب المؤلف، كذلك الإلحادَ الذي يزكِّي الانغلاق النسقي الملِّي حين ينتصرُ لانغلاق آخر لرفضه. المثير في الكتاب أنه يستحضر نصوصَ العرفاء في جلِّ تصديراتِ فصولهِ، مما يدلُّ على فعالية الخاصية التبديدية للنصِّ العرفاني اللانسقي في فتح فهم القرآن الكريم، ومن خلال تلك الخصيصة البنائية فيه، على أفق إيماني حر، يرفض الأنساق المغلَقة التي أقفلت قراءة النص، ونقلته من “التبديد” إلى “التحديد”. إن ذاك الاستدعاء لنصوص العرفانين، هو استدعاء لخاصية انفتاح النص القرآني وحرية تشكيل آفاق إيمانية حرة، أي خارج الانغلاقات النسقية للقراءة الموروثة للنص القرآني.
ربما كان علينا إعادةُ قراءة “التلقي العرفاني” للنص القرآني، سواء بالفهم الإشاري، أو التمثل السلوكي الأحوالي، أو التلقي الجمالي العرفاني من خلال الشعر والحكاية والفنون؛ مع فهم كل ذلك ضمن مسارات هذه الخصّيصة المنفتحة لأنفاس النص وإيحاءاته. تلك الأنفاس التي تصبُّ في “نغمة الألوهية” المتفرِّدة التي تُميِّز آيات القرآن الكريم. يكتب أحمد القبانجي: “”كل شخص يقرأ القرآن حتى القرآن المترجم إلى لغة أخرى يدرك جيدا أن الله هو الذي يتحدث معه بـ”نغمة الألوهية”، وأن البشر لا يمكنه الإتيان بمثله من هذه الجهة، أي من جهة النسبة إلى الله تعالى”[10]. كما نقرأ لعبد الله العروي يقول: “عزفت طويلا عن مطالعة مراجع الآخرين، توراة اليهود وأناجيل النصارى، حتى سافرتُ يوما إلى إحدى البلاد البروتستانتية حيثُ توضعُ نسخة من كتابهم المقدس في مجرّ على رأس كل سرير في الفنادق. استيقظت أثناء الليل ولم أستطع معاودة النوم ففتحت المجرّ وأخذت الكتاب. لم أتجاوز الصفحة الأولى إذ لم أجد فيه ما أجد في القرآن، تلك النغمةَ التي ترغمني على مواصلة القراءة”[11]. إنها النغمةُ التي تدِبُّ في أوصال تلك اللانسقيةِ الظاهرةِ في لغة الوحي؛ تلك النغمة التي تفتَح النصَّ على مُطلقِهِ، والتي كان يسْكرُ بحيرَتِها العارفون، حتى إن بعضَهم سكَنَته ونطقَت فيه بـ”أناها”، فلقيَ حتفَهُ حين لم يستطِع كتمَ صبابتهِ بها وظهور عدمهِ في وجودها[12].
———
[1] – العروي، عبد الله، “السنة والإصلاح“، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،2008 ، ص.74.
[2] – راجع: أركون، محمد، “قراءات في القرآن“، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، 2017، ص.82.
[3] – Bidar, Abdennour ; «Un islam pour notre temps» ; Seuil, 2017 ; p.98-99.
[4] – راجع : الحراق، محمد التهامي، “في الجمالية العرفانية..من أجل أفق إنسي روحاني في الإسلام“، دار أبي رقراق، الرباط، 2020، ص. 36-37.
[5] – بنعبد العالي، عبد السلام، “جرح الكائن“، دار توبقال، الدار البيضاء، 2017، ص.125- 129.
[6] – راجع، مثلا، كتاب إيان ألموند، “التصوف والتفكيك – درس مقارن بين ابن عربي ودريدا”، ترجمة حسام نايل، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2011، أو كتاب خالد بلقاسم، “الكتابة والتصوف عند ابن عربي“، دار توبقال، الدار البيضاء، 2004… إلخ.
[7] – نشرت أعمال هذه الندوة ضمن كتاب: “ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة“، تنسيق محمد المصباحي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2003.
[8] – المصباحي، محمد، “نعم ولا، ابن عربي. والفكر المنفتح“، منشورات ما بعد الحداثة، فاس 2006، ص.53-60.
[9] – المسكيني، فتحي، “الإيمان الحر أو ما بعد الملة…مباحث في فلسفة الدين“، مؤمنون بلا حدود، بيروت- الرباط، 2018.
[10] – القباجي، أحمد، “سر الإعجاز القرآني..قراءة نقدية للموروث الديني في دائرة الحقيقة القرآنية وتأصيل الإعجاز الوجداني“، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2009، ص.126.
[11] – العروي، عبد الله، “السنة والإصلاح“، المركز الثقافي العربي، الدر البيضاء، 2008، ص.78.
[12] – راجع: “الحلاج شهيد النغم”، ضمن كتابنا: “مباسطات في الفكر والذكر“، دار أبي رقراق، الرباط، 2019.
[13] – مجلة “يتفكرون“، العدد 11/2018.
[14] – نفسه، ص.152.
[15] – “قراءات في القرآن”، م.س، ص.82.
[16] – العروي، عبد الله، “نقد المفاهيم“، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء 2018، ص. 114.