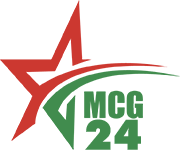أي حاجة للتصوف في زمننا الراهن؟
محمد التهامي الحراق
بدار الضمانة (وزان) حيث توهج الذاكرة الروحية لزاوية شأوها في التاريخ كبير، تشهد عليه منارات وقباب وأزقة ومزارات المدينة وحكاياتها، وحيث الماضي المشرق لا يكاد تصدقه الأجيال الجديدة جراء واقع اجتماعي عسير و وضع معماري كليم على مرآته تتهشم تلك الذاكرة الروحية الباذخة، كانت قد بادرتْ كل من “جمعية الصفا لمدح المصطفى بوزان” و “رابطة مجمع الصلاح بالمغرب” بتنسيق مع المجلس البلدي والمجلس الإقليمي، إلى عقد ندوة فكرية يوم 12/12/2015م، حول موضوع رأت الجهات المنظمة أن يكون مدخلا “وزانيا” للتأمل في الراهن الديني والروحي اليوم، وهو المدخل الذي صيغ في استفهام استشكالي: “أي حاجة للتصوف في الزمن الراهن؟”، و قد عُقِدَت أخيرا حلقةٌ ثانية لمتابعة فحص ذات الاستفهامِ، نظمها بدار الجنوب بالرباط يوم 13-04-2016م “نادي الفكر والإبداع”.
خلال الحلقتين، تعاقبَ على التأمل والتفكير في هذا الاستفهام، كل من د. حسن أوريد، ود. عبد الإله بن عرفة، ود. عبد الله شريف الوزاني، وكاتب هذه الإشراقة. ولمَّا كانت الحلقتان غنيتين بما طُرِح فيهما من أفكار وأسئلة وآراء ومسارات تحليل وتفكر، بدا لي مفيداً، وبعيداً عن كل نية في تلخيص المداخلات ونقاشاتها، أن أعرض لبعض النقاط التي أثارت اهتماما استثنائيا لدى حضور متميز وعيا وتفاعلا بكل من وزان و الرباط.
أ- أكد الأستاذ حسن أوريد، في الحلقتين، على جملة أفكار من أبرزها التميز المغربي في تناول المسألة الدينية، مشيراً إلى مركزية عنصر رئيس في المسار التاريخي للدولة المغربية، وهو “تعلق المغاربة بآل البيت”، ومؤكدا على الإرث الروحي الكبير الذي يؤهل المغرب، دون باقي دول المنطقة لتقديم نموذج في التدين متميز وقادر على مجابهة أشكال التشدد التكفيري التي مست حضور الإسلام اليوم، والتي شوهت صورته الحضارية والإنسانية و الجمالية في التصور الغربي والعالـمي المعاصر. و قد عرض الأستاذ أوريد في وزان لمختلف المراحل التي ميزت التفاعل المغربي مع الأحداث التي تبلور من خلالها العنف باسم الدين الإسلامي، وصولا إلى أحداث 16 ماي 2003، وتميُّز “الرد المغربي” عليها، وما تلاها من مبادرات مختلفة كان من بينها مباشرة إصلاح المؤسسة الدينية تحت عنوان “إعادة هيكلة الحقل الديني” على مستويات الخطاب والمؤسسات والتأطير، مُثَمِّنا هذا المسار، و داعيا بعد العشرية الأولى من هذا المسار إلى الرفع من وتيرته والمرور إلى السرعة الثانية في مساره، أو ما سماه في لقاء الرباط بالجيل الثاني من هذا الإصلاح، والذي رأى أنه يتمحور حول “تجديد الخطاب الديني”. هذه الرؤية نفسها تبناها في اللقاءين الأستاذ عبد الإله بن عرفة، معتبرا أن المغرب قوة روحية تتجاوز حدوده الجغرافية، وداعيا، على غرار الأستاذ أوريد، إلى ضرورة استثمار هذا الرصيد الحضاري والروحي الـمتفرد من أجل معالجة أشكال التشويه التي تطول الدين الإسلامي وصورته اليـوم في العالم.
إن هذا الأفق الذي نزكيه له أبعاد شتى، ليس أقله ما تشكله اليوم مؤسسة “إمارة المومنين” في المغرب من سند رئيس لكل أمن روحي، و ما تشير إليه من رمزية دينية وهوية حضارية عميقة. و هي المؤسسة التي كان يعتبرها البعض إلى وقت قريب “احتكارا للدين” وتجاوزا في الصلاحيات وتمددا في السلطة، إلى أن أدرك أغلبُ الفرقاءِ اليوم أن الأمر يتعلق بإطار روحي ورمزي ناظم لتنوع مختلف مكونات الهوية المغربية؛ ذلك أنها تشكل المَصْهَر الروحي الذي تتواشج وتتوالج فيه كل الروافد العربية والأندلسية والأمازيغية والحسانية والصحراوية والعبرية، مثلما أنها تشكل الضمان الرئيس لعدم التسخير الفئوي أو السياسوي أو الظرفي لما يشكل العنصر الموحد لمختلف تنوعات المجتمع المغربي اللغوية الثقافية والإثنية، مثلما تحرص على صيانة “التدين المغربي” بمميزاته العقائدية والفقهية والسلوكية التي تتميز بوسطيتها وبعدها عن المنزع التكفيري (العقيدة الأشعرية)، والاجتهاد المتواصل للنظر الفقهي في النوازل بما يلائم بين فقه النصوص و فقه الواقع (مرونة أصول الاستنباط في المذهب المالكي)، فضلا عن اعتبارها للبعد التزكوي للنفس ترسيخا لمكارم الأخلاق في الجوارح والجوانح فرداً وجماعة (التصوف الجنيدي)؛ دون أن يعني هذا أي تعصب مذهبي، بقدر ما هو أخذ بتمييز أصيل بين ما يشكل وحدة المتدينين في الممارسة الدينية للمغاربة، وبين غيرها من أشكال التدين والممارسات الدينية المشروعة التي تمثل ثراء عقديا وفقهيا وسلوكيا في الممارسة التاريخية المتعددة للإسلام الواحد. و قد كان لزاما علينا في الحلقتين، من أجل بسط هذا الوعي، التذكيرُ بالفرق بين الدين بما هو نصوص وحيانية متعالية و ثوابت عقدية و عبادية و أخلاقية و سلوكية تمثل وحدة الإسلام بما هو دين، و بين التدين من حيث هو تنزيل اجتهادي لتلك الثوابت في الفضاء الجغرافي والأنتروبولوجي المتغير و في التاريخ الاجتماعي و الثقافي المختلف و الدائم الصيرورة، فعن هذا الوعي يصدر حديثنا عن خصوصية “التدين المغربي”، أي الممارسة المغربية للتدين، ضمن رحابة الانتماء للدين الإسلامي الواحد.
ب- انطلاقا من الوعي المذكور بهذه الخصوصية، التي لا تعني كما أكد ذلك الأستاذ ابن عرفة تسليما بكونية غيرها بقدر ما تشكل بصمتنا المتميزة في هذه الكونية، رام المتدخلون إبراز أوجه احتياجنا للتصوف اليوم، حيث ذكَّرَ الأستاذ عبد الله الوزاني بما يزخر به التصوف من أبعاد روحية و تربوية عميقة تقوم على تزهيد الناس في التعلق الجشع بملذات الدنيا ومباهجها، وعلى تمكين الفرد من مجاهدة نزواته وتطويع نوازع الشر والعنف فيه، فضلا عن تطهير قلبه من مختلف الأمراض والعلل التي تزري فيه بالإنسان، وتجعله يستمرئ إقصاء أخيه الإنسان، إن لم نقل إهدار دمه، باسم الإله الرحمن الرحيم. وهذا ما يجعل التصوف، بما هو علم سلوك وتربية يعمق المستوى الإحساني في ثلاثية الدين الإسلام والإيمان والإحسان، مثلما يجعله أحد المستندات الضرورية لترشيد حضور التدين في راهننا اليوم.
والمغرب بفضل ميراث تاريخه الروحي والمدد الرمزي لأوليائه وزواياه ومدارسه العرفانية، قادر بقوة على الإسهام في هذا الترشيد الملح اليوم. وهنا طُرِح سؤال قدرة “الممارسة الصوفية” اليوم على الاضطلاع بهذه المهام، حيث نبه ابن عرفة إلى ضرورة عدم تقييد التصوف اليوم بمؤسسات الصلاح (أي الزوايا) التي أصابَ الكثيرَ منها العَطَلُ، بل دعا إلى مرحلة جديدة أطلقها عليها “التصوف ما بعد الطرقي”، وهي مرحلة تخرج التصوفَ من الانحصار في كيانات طرقية، وتسعفه في الذهاب نحو وسع معرفي عرفاني كان أهلُ التصوف دائمي السعيِ إليه، من خلال التجديد المستمر لمساراتهم الروحية و التربوية، و كذا من خلالِ ممارستهم الدائبةِ للنقد الذاتي باسم “الحسبة” بين أهل النسبة، وهي ممارسةٌ تُعنى بترشيد تلك المساراتِ وفق معيارية الكتاب والسنة وسير السلف الصالح من أهل الولاية، وهو ما يجب استئنافه اليوم. و قد سبق أن أكدنا في غير ما موضع على ضرورة تجديد عمل الزوايا لإقدارها على الاضطلاع بالمهام التربوية والروحية النفيسة التي نحتاجها اليوم.
ج- خلال المناقشة الغنية التي تلت المداخلات، في اللقاءين، أثيرت قضايا غاية في الأهمية، حول تعثرات ترشيد الممارسة التدينية اليوم، وكذا حول الارتباك الذي يطول فهم “الإسلام الصحيح” جراء تضارب الخطابات وتعدد المتحدثين باسم الدين في عالم مفتوح إعلاميا، مثلما أثيرت مسألة الإنصات إلى الإحراجات التي تعتري فهم الشباب للدين؛ وخصوصا للتصوف عند وصله بجملة من “الممارسات” الطقوسية التي تتأرجح في تلقيهم بين التمجيد والتنديد، فضلا عن غياب الحضور العلمي القوي لتفكيك مفاهيم ومستندات الخطاب الديني التشدُّدِي، بناء على منهجيات علمية وأساليب تواصلية معاصرة قادرة على الإقناع وتبديد مختلف أشكال الالتباس التي يطرحها غياب هذا العمل التفكيكي الرئيس لمنابع هذا التشدد، كما طرح جنيالوجيتها الأستاذ الوزاني في لقاءِ الرباط.
د- لن أعود هنا بتفصيل إلى ما طرحتُه في اللقاءين، وإنما أذكر فقط أنني، وتفاعلا مع مختلف هذه الأفكار، رصدت خمس آفاتٍ يعاني منها تديننا اليوم، وصفتُها بـ”السينات الخمس”؛ وهي آفة “التسييس”، وآفة “التطقيس”، وآفة “التلبيس”، و “آفة التيئيس”، و “آفة التعبيس”؛ ذلك أن الزج بالدين في تفاصيل قضايا سياسية ظرفية ذات رهانات متقلبة تتجاذبها أجندات ومصالح وخلفيات اقتصادية وجيواستراتيجية لا صلةَ مباشرةَ لها بالدين ومقاصده الـمتعالية، و اتخاذَ الدين مناطَ صراع بين الناس بدل أن يكون مناطَ توجيهٍ أخلاقي لوجودهم في مختلِف مراتبه، و أداةَ تقريبٍ روحي بينهم من منظور إنساني رحموتي؛ كل ذلك يجعلنا إزاء تدين مفصول عن الأخلاق، وهذا ما سميته بـ”آفة التسييس”؛ على أن تعطيل روحانية الدين في بعده الروحي الـمتعالي يُحَوِّلُ شعائرَه ومناسكه إلى مجرد طقوس شكلانية بلا معنى، لكونها تكف عن أن تُثْمِرَ رشدا أخلاقيا و”استقامة” سلوكية، وهذا ما يجعلنا إزاء تدينٍ بلا روحانية، و هو ما سميته “تطقيسا”؛ أضف إلى ذلكَ أن الصراعَ الشرس على النطق باسم الإله في الأرض، وادعاء امتلاك الحق الـمطلق و”الإسلام الصحيح” في عالم مفتوح، يجعلُ “الـمؤمن” إزاء أشكال تدينية متنافرة، كل منها يدعي أنه الممثل الأسمى للدين الحق (الفرقة الناجية)، بعيدا عن القدرة العقلانية على صياغة فهم للدين ضمن الـمعقولية الحديثة المؤسَّسَة على القبول بالتعدد وشرعية الاختلاف وتمجيد حقوق الإنسان والإعلاء من رابطة الـمواطنة…إلخ، و وضعٌ كهذا ما يفتأ يخلق ارتباكا ذهنيا و وجدانيا لدى المؤمن، حيث يجد نفسه إزاء تدين منافر للمعقولية الحديثة، أي إزاء تدين بلا عقل، أو قل إزاء تدينٍ يتعارض فيه الإيمان و العقل و يلتبس فيه الحقّ بالباطل، و هو ما أطلقتُ عليه “تلبيسا”؛ ثم إن تغييبَ الأخلاق والروحانية و العقلانية من ممارسة الدين، يلقي بنا في أتون تدين عاجز عن بعث الأمل في المؤمن، و عاجز عن بناء علاقة هذا الأخيرِ بربه و بذاته و بمحيطه و بالوجود بناءً منشرِحاً بروحِ محبة متجددة، تغذي فيه ظمأ فطريا و أنطولوجيا للمعنى، عجزٌ يُحوِّلُ التدينَ إلى مصدر يأس وعَدَمٍ بدل أن يكون منبعَ أملٍ و معنى، و هذا هو ما نعنيه بآفة “التيئيس”؛ و طبيعي أن اليائس الفاقدَ للأملِ والمعنى لا يرى في الوجود جمالا، بل إن يأسَه هذا يُحِلُّ ثقافةَ الكراهة والموتِ محلَّ ثقافة المحبة و الحياة، مما يظهر في رؤية عبوسةٍ سوداوية للعالم، تجعلَ التديُّنَ مخاصِما لـمختلِفِ أشكالِ الجمال، وهو ما قصدناه بآفة “التَّعبيس”.
وإزاء الآفاتِ الخمس، فإن التصوف، وبَعد إجراء نقد ذاتي لبعض الممارسات غير الرشيدة التي يسلكها بعضُ المنتسبين إليه و تجديدِ قراءة ميراثه العرفاني، كفيلٌ بالإسهام في ترشيد التدين من خلال “تخليق” فهمِ الدين بإحياء بعده القيمي المتعالي وانتشالِه من أوحال السياسوية، وكذا من خلال “روحنته” عبر العمل على بعث التثمير الروحي لمناسكه وشعائره، وكذا من خلال “أنسنته” التي من شأنها أن تحيي روحَ الدين المشيَّدة على العقل و الأمل و المحبة و الجمال في خدمة “الإنسان”، باعتباره أسمى قيمة في الوجود، وحاملا للأمانة الإلهية وخليفة الله في الأرض ونفخته الروحية الأزلية، وهو ما من شأنه أن يسهم بقوة وفعالية في رفع الآفات الخمس التي تطوق التعامل التشددي مع الإسلام اليوم.
إن هذا النقاش النفيس، الذي خَلُصَ إلى الإقرار بحاجتنا اليوم إلى التصوف بشرط الاقتراب النقدي و تجديد الفهم، يفتح آفاقا كبيرة لتعميق التأمل في أحوال الإسلام اليوم؛ فمن خلال العمق الروحي لنموذج التدين المغربي يمكننا الذهاب بعيدا في تقديم أفقٍ لفهم الدين و ممارسته يلائم المجال التاريخي و الحضاري المغربي، بقدر ما يطرح نموذجا تدينيا قادرا على الوفاء لروح الدين و لروح الحداثة في الرهانات المعاصرة. و هو ما من شأنه أن يضطلع بدور رئيسٍ في إنقاذنا من مأزق التشددية الدينية التي تروم اليوم اختطاف الإسلام، و في إنقاذنا كذلك من أزمة المعنى التي تزج بنا في مأزقها الحداثةُ الماديةُ الاستهلاكية. على أن الإسهام في هذا الإنقاذ المزدوج لن يتأتى بغير استثمار الإمكانات الزاخرة للذاكرة الدينية والروحية الـمغربية في محاصرةِ التشددية الدينيةِ التي تهدد الراهنَ الإسلامي، مثلما لن يتأتى بغير تثمين نموذج مغربي أصيل ومنفتح في التدين ذي قدرة كبرى على الاستجابة للرهانات المطروحة اليوم على حضور الدين في العالم بوجه عام؛ خصوصا وأن المدخل الصوفي في التدينِ المغربي، بما هو مدخل روحي رحموتي ومعرفي جمالي وإنسي وكوني، يقدم إمكانات قرائيةٍ استثنائية لتميز هذا النموذج في تفكيك التشددية الإسلامية من جهة، و في إعادة الاعتبار للدين و لتعاليه في الحداثة و بها من جهة ثانية.