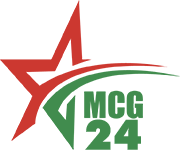محمد التهامي الحراق
لقد أُهمِلت جماليةُ اللغةِ الصوفية من لدن النقد العربي القديم لأنّها لم تجدد فقط على صعيد اللغة، بل لأنها هتكت وخرقت وتجاوزت الخلفية المؤطِّرة السائدة. لنقل إن جماليةَ اللغة الصوفية خرقت اللغة السائدة والمعتادة ليس فقط على صعيد التعبير والأسلوب والتركيب والبناء، وإنما أيضا على صعيد المرجعية؛ ذلك أنها عملت على إخراج المعاجم الطبيعية والغزلية والخمرية وغيرها من السياق الدنيوي والفضاء الحسي والبعد الظاهري واللاهي إلى السياق الديني والفضاء المعنوي والبعد الباطني الروحاني الإلهي، هذا الخرق كان مصدر تفجير وخلق. لنتذكر أن صراع القدماء والمُحْدَثين كان يرجع، في خلفيته، إلى دور الشعر ووظيفته التي حصرها اللغويون في الإضاءة اللغوية للنص الديني، أي في استحضار الشعر كشاهد لغوي أو نحوي أو بلاغي…، وبالتالي فإنهم لم يهتموا بالشعر في حد ذاته، ولا بالنظر المخصوص في أبعاده الفنية والجمالية. ولما بدأ الشعرُ المُحْدَث يجدّد أساليبه وصوره ولغته فإنه تنطع لتلك الوظيفة اللغوية التي أُسنِدت إليه من قبل اللغويين والنحويين والبلاغيين، وهو ما أفضى إلى مجابهته ورفضه من قبل أهل القدامة، فكيف بالشعر الصوفي الذي خرجت جماليتُهُ عن المرجعية الفقهية الظاهرية، وأعادت بناء معجمِها وصياغة معطياتها صياغةً جديدة تستجيب للمصدر الجواني للمعرفة الصوفية.
لعل هذا الاختلاف في التعاطي مع المرجعية هو واحد من أبرز العوامل التي أفضت إلى إلغاء النص الصوفي من حقل النقد، وطرحه في هوامش الإهمال والنسيان؛ لأن سلطة الفقهاء في المجتمعِ اعتبرت النص الصوفي العالي في رمزيته وإشارته نصا بِدْعِيا، أي خارجا عن رسوم الشريعة. ومعلوم أن هذه المرجعية الفقهية اللغوية هي التي ظلت غالبا معتمَد السياسة الرسمية، وسندَ الأمراء، بل مصدرا لشرعيتهم الإديولوجية، لذلك امتدَّ الموقفُ التعليمي الرسمي القاضي بإلغاء النص الصوفي من برامج التعليم إلى اليوم، وزكته السلفياتُ اللغوية والفقهية والشعريةُ عبر التاريخِ. لكن جماليةَ النصّ ظلت متوهجةً، إذ ما فتئت لغتُه تستدعي عشاقََها من المُتيَّمِين بما يميّز ملامحَها من سحرِ السفر وسفرِ السحر.
* * *
بمجاورة اللغة الصوفية ومحاولة الاقتراب من ملامحها وتقاسيمها بل وطواسينها، نستشف أن جماليةَ هذه اللغة تمتح خصوصيتها من مصدرها، وهو التجربة الروحية الباطنية الصوفية التي يخوضها الصوفي بأحوالها ومقاماتها ومنازلها ومعارجها وسفره الروحي في مراقيها من مجاهدة النفس إلى مكاشفة الحق. وسواء أكانت هذه اللغة لغة نص صوفي نثريّ أم شعريّ فإن انبثاقَها من تلك التجربة بعنفوانها الجوانيّ يطبعها بسمات جمالية وفنية مخصوصة ترتبط بالمرجعية المتعالية التي تنغرسُ في “أديمِها” اللغةُ الصوفية. على أن النص الصوفي المعني هنا هو ذاك الذي ينفجِر ويتدفَّقُ من صميم التجربة الصوفية ليحاولَ تفجير تلك التجربةِ بالدفع باللغة إلى أقاصيها الاستعاريّة وضفافِها المجازية، وتحريك أمواج الدلالة الإيحائية المتناسِلَة والمتجدِّدة من خلال الترميز والتأشير (من الإشارة) الصوفيين، ونُسقِطُ من اعتبارنا هنا الأشكالَ الأخرى للكتابة الصوفيةِ كالنصّ التعليمي الصوفي والرجزِ الصوفي أو كتبِ الطبقات؛ أي كلّ نصّ صوفي لا يحتفي بالإشارةِ ولا يَنبُض بحرارةِ التجربة الصوفية. النص الذي نعنيه هنا، أساساً، هو ذاك الذي يُحاول أن يقولَ التجربة في أوج توهُّجِها الباطني؛ سواء أكان نثرياًّ أو شذراتٍ وأوراداً وصلواتٍ ودعواتٍ ومناجياتٍ،… أم شعرياّ منظوماً عمودياًّ ومُوشّحا وزجَلا أندلسياًّ وملحوناً (أي شعرا منظوما بالعاميةِ المغربيةِ). نرصد هنا، إذن، بعضَ سمات جماليةِ لغة هذا النص الصوفي المتوهج على ما بين مستويات هذا النص من تنوع وتعدد وثراء، أي تلك السمات التي تجعل من ذاك النص في تنوعه نصاًّ صوفيا عاليا أو قل نصاّ صوفيا إبداعيا.
* * *
تصدر النصوصُ الإبداعيةُ والأدبيةُ والصوفية عن تجاربَ روحيةٍ باطنية، وتتفتَّق عن أسفارٍ سرية نورانية، وتتقلّب بين مقاماتٍ وأحوالٍ خلالها يجتاز الصوفيّ السالكُ مراحلَ ومنازلَ ومراتبَ ومراقيَ ودرجات، يصعَدُ ويرقى فيها من الفقيرِ المريدِ إلى السالكِ إلى الواصلِ فالعارف. ومن رَحِمِ هذا السيرِ الباطني وهذه الرحلةِ القلبية، في الله وإلى الله وبالله، يتدفَّقُ وينبثِقُ ويفيضُ النصّ الصوفيّ الإبداعي، فيتَلَوَّنُ النصّ بوقتِ الصوفي والأحوالِ التي تتلبسُه، مثلما يتبلَّلُ بمعالمِ المقاماتِ التي يُقيمُ فيها، وهو ما يظهر ويتجسدنُ في “أخلاقِ” اللغة الصوفية، أعني “أخلاقَها” الجمالية، وتقاسيمَها وعتماتِها وملامحَها المعجمية والتركيبية والدلالية والإيقاعية، وهنا نستبينُ أولَّ سمةٍ نلتقطها من سمات جماليةِ اللغة الصوفية؛ أعني مصدَرها الروحانيّ الجواني، مما يجعلنا ننعتها بكونها لغةً “باطنيّة”.
* * *
ثم إن ما يميز جماليةَ اللغةِ الصوفية، أيضا، احتفاؤها بقسماتِها وتقاسيمِها؛ ذلك أن “باطنيةَ” هذه اللغةِ تجعل “جسدها” بمختلف قبساتِه وعتماته يتسم بجماليةٍ روحانيةٍ وروحانيةٍ جمالية، وينبعُ هذا من ذاك الوصلِ السريّ والعُضويّ الذي يتفرَّدُ به النصُّ الصوفيّ بين ما هو فكريّ معرفيّ تنتظمُه المفاهيمُ، وبين ما هو جماليّ فنيّ إبداعيّ ترسمُه الصور. وهذا هو ما يُعبِّر عنه بهَيْبة وبهاءٍ مفهوم “الرؤيا” بما هو معرفة إشراقيةٌ باطنيةٌ كشفيةٌ يتعانق ويتضارعُ ويتصاهرُ ويتذاوبُ فيها الفكريّ المعرفيّ بالجماليّ الفني، والمفهوميّ بالخياليّ، فتتصدع الحدودُ بين المنطقِ والخيال، وتذوبُ التخوم وتتلاشى بينهما، فيتداخل العمق الفكري برحابةِ المتخيّل، الأمر الذي يتمظهر في بهاء اللغة الصوفية التي تشقّق الرؤيا المنبثقة والمشرِقَة من فرادة خصوصية وذاتية وذوقية التجربة الصوفية التي تخوضُها الذاتُ المتصوفة المبدِعة، هكذا تكون “الرؤيوية” هي السمة الثانية (إجرائيا لا ترتيبا) التي تُميّز جماليةَ لغة الواجدين الإلهيين.
* * *
السمة الثالثة لجمالية اللغة الصوفية هي “برزخيّتها”، فهي جِسْرٌ وعتبةٌ بين تجربة باطنية روحية مُقَدَّسَة ملكوتية، وعالم نسبيّ تاريخيّ أرضي بشري مُلكِي. وتتجلى هذه “البرزخيةُ” وتبرُز في ذاك التماسّ بين معرفةٍ لدنيَّةٍ كشفيةٍ إشراقيةٍ غيبية ذوقية، وبين لغةٍ نسبيةٍ تاريخيةٍ أرضيةٍ حسيةٍ بشرية. هذه البينُونَة بين طبيعةِ المعرفةِ الصوفية وطبيعة اللغة المتداولة هي التي أدّت إلى جعل اللغة الصوفية لغةً “برزخية”؛ تسعى إلى الجمع بين بحري الأواني والمعاني، والمزاوجة بين عالم الأشباح وعالم الأرواح، وهو ما يتعذَّر “عقليا”، و”منطقيا”، الأمرُ الذي يُفسِحُ المجالَ للمجاز الذي به تحاول أن تجوزَ الحقيقةُ الباطنيةُ إلى الانكشاف؛ لذا دعا المتصوفة إلى التحرر من عِقال “العقل” ولغة العبارة، والتبلّل من بحرِ الذوق ومجازات الإشارة.
* * *
إنها “الإشارية”، السمة الرابعة من سمات جماليةِ لغة الواجدين الإلهيين، كما تنبجسُ في مسار التقاطنا، وإلى هذه السمةِ تُفضي “البرزخية”؛ إذ “الإشارية” هنا نوع من الظلال التي تدُلُّ على الصدى ولكنها لا تُجسِّده، وتشير إلى المعاني دون أن تقولها؛ فهي آثار للمعنى الصوفي، وصدى للمعرفة الذوقية، شأنُها في ذلك شأن العالَم الذي هو في عينِ قلبِ الصّوفي مَجَازٌ وصدى. إنه ظِلالٌ وأفياءٌ وألوانٌ لحقيقةٍ أزليةٍ باطنيّة يحاول الصوفي استبطانَها بأساليبه الكشفية اللطيفة، واستذواقَها بالطرائق الحدسية الإشراقية. فالعالَم إشارات، ولغة الصوفي تتخذ من العالَم، ماثِلا في اللغة، مَطيةً لمغامرتها. إنها “تغامِر” بالعالَم اللغويّ لتشيرَ إلى العالَم المُطلق المتعالي؛ هذا الأخير الذي من آباره تهُبُّ نسماتُ العرفانِ المتعالي على القلب، مَسكنِ المحبوبِ المُطلق، فتحيلُه رائيا ومجلًى لذاك التعالي في ذات الآن.
بهذه المثابة، تتقدم اللغةُ الصوفيةُ كلغة باطنية رؤيوية برزخية إشارية، سماتٌ بها يُوَقِّع الواجدون الإلهيون جماليةَ “كلامهم” وفرادتِه، أو معالِم لغتِهم الوجديةِ داخلَ اللغة، وبتلك السمات تتحدّد طبيعةُ تلقي هذه المعالِمِ، بل وترتسِمُ آفاقُ الحيرة ببهائها، والاحتفاء المُطرِب والراقصِ، الصائت والصامت، بطواسينِها.