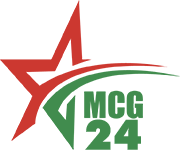حول “مكانة المرأة في الإسلام”: نحوَ فهمِ تنويري -1-
محمد التهامي الحراق
تثيرُ “مكانةُ المرأة في الإسلام” اليومَ أسئلةً إشكاليةً ما تفتأ تزجُ بالخطاب الديني السائد في إحراجاتٍ شتى؛ بل ما تبرحُ تَلفِظُ العديد من الأجوبة، التي يقدمها هذا الخطاب بوصفها “مُسَلَّماَت دينيةً”، في حلبة الارتياب والارتباك. وترجعُ تلك “الإحراجيَةُ” التي تستبدُّ بالخطابِ الديني، كما يرجِعُ الارتياب والارتباك اللذان يمسان بعض “مُسَلَّماته” عن المرأة المُسلِمةِ، إلى ما عرفته المجتمعات الإسلامية من صيرورة وتحول؛ سواء على مستوى المعيشِ أو على مستوى الوعي. وهي تغيراتٌ غيرُ متعلقةٍ بالدين في حد ذاته، بل تتعلقُ، أساساً، بكيفية فهمِ ومقاربةِ تلك الأسئلة في ضوء نصوص الدين التأسيسية وتفسيراتِ الأجدادِ لهذهِ النصوص، وكذا في ضوءِ تعاطي الخطاب الديني، معرفيا وتشريعيا، مع الإشكالاتِ التي ما تفتأُ تتناسلُ حول “صورةِ” المرأة و”حقوقها” بتحايث مع تلك التغيرات.
1- مداخلُ من أجل تنويرِ الفَهم
حتى نستطيعَ الإسهامَ في رفعِ قُلٍّ من إحراجاتِ الخطاب الديني السائد حول المرأة، تلزمنا مداخِلُ -أخالُ أننا في مسيس الحاجة إليها- من أجل تنوير وتثوير “الفهم السائد” للدين، علَّنا نصلُ إلى نتائجَ فعالة قادرةٍ على المشاركة في تجديد علاقة المؤمن والمؤمنةِ بالإدراك المعرفي لدينهما وبالاستبطانِ الوجداني لمعانيه؛ الأمر الذي من شأنه أن يضمن لهما انسجاما، يكادُ يكون اليوم مُرتَبِكاً في الغالبِ، بين مقتضيات روحِ الإيمان ومقتضياتِ روحِ العصر. وتُعتبرُ أسئلةُ “مكانة المرأة في الإسلام” من أبرزِ ما يُظهِرُ قلقَ ذاك “الانسجام” في الخطاب الديني الراهن؛ لا سيما وأن تلكَ الأسئلةَ تضرِبُ بعمقِ في التُّربةِ التيولوجيةِ، مثلما تَنغرسُ في الحقولِ الاجتماعية والثقافية والحقوقية والتعليمية والإعلامية، فضلا عن كونها تتعلّق بقضايا تهم مختلف شرائح المجتمع، وتطرحُ على الوعي مفارقات الخطاب الديني قياساً إلى مآزقِ الممارسة التدينية وانشراخات تنزيلِ القيم الإسلامية المعيارية في ملابَساتِ المعيش اليومي. وقد أُتيحَ لي أن أقِفَ بشكل مباشر على بعض هذه “الانشراخات” بالاستماعِ إلى حكايا معاناة مريرة وإفضاءات نسائية قاسية على إذاعة “أصوات” المغربية الخاصة خلال حلقتين من برنامج “حديث ومغزل“، استضافتني فيهما الإعلامية المتميزة سناء الزعيم، وخصصَتهما لموضوع “صورة المرأة في الثقافة الدينية الشعبية“[1]. كما قرأتُ أصداءً لذاتِ “الانشراخاتِ” في النقاش “الجَمْري” الملتهِب الذي عرفهُ الصالون الثالث لـ”نادي الإبداع والفكر” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؛ وتعييناً ذاكَ المتصل بـ “الأسئلة الحرجة” حول المسائل السبع التي طُرِحَت خلال هذا اللقاء بخصوص المرأة المُسلِمة: الإرث؛ القوامة؛ التعدد؛ الشهادة؛ الضرب؛ العصمة؛ الحجاب[2]. وهي مسائلُ تقتضي تناولاً نقديا تنويريا طلباً لتبديد “الإحراجية” العالقةِ بها، ومن ثم، الإسهام في تجاوز بعض تلك “الانشراخات” التي تنجمُ عن هذا الإحراج.
يتمثل المدخلُ الأول إلى التناولِ التنويري لمختلف هذه الأسئلة وما يشاكلها، في نقطةٍ رئيسةٍ يجبُ الاتفاقُ حولها، وهي نقطةٌ تتصدّرُ أيَّ نقاش يطولُ “أسئلة” الدينِ بوجه عام، وقوامُها ضرورةُ التمييز بين “الدين في ذاته” وبين “فهم الدين”؛ ذلك أن الدينَ واحدٌ في ذاتهِ، فيما الاختلاف والتعدد من طبيعةِ الفهم البشري للدين، ومن ثمَّ لا يمكن أن “نؤثِّمَ” المختلِفَ في الفهم متى أنتجَ فهماً يؤسسهُ العلمُ وتسوِّغُهُ المعرفةُ لا الأهواءُ وتقلباتُ المزاج. وبهذا نقبلُ بشرعية الاختلافِ بين فهوماتٍ متأصلَةٍ ومبنيةٍ علمياً تقبلُ بدورها “الأخذ والردَّ”؛ إذ “كلٌّ يؤخذُ من كلامِهِ ويُردُّ إلا صاحبُ هذا القبر” كما أُثِرَ عن الإمامِ مالك وهو يشير إلى قبر النبيe. ويتحقق هذا “الأخذ والرد” من خلال حوار علميٍّ أداتهُ المعرفة التي لا يجبُ أبداً تجميدُ البحثِ فيها من أجل تطويرها وتجديدها؛ وأخلاقهُ أن “رأيي صوابٌ يحتملُ الخطأ ورأي غيري خطاٌ يحتملُ الصوابَ” إذا استعرنا عبارة سائرة للإمام الشافعي. الأمر الذي يقتضي التخلّي عن تقديس “الآراء” البشريةِ مهما كانَ صاحبُها؛ إذ “الرجالُ يُعرفون بالحق ولا يُعرفُ الحقُّ بالرجالِ” كما اشتهر عن الإمامِ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. على أن التخلي عن هذا التقديسِ لا يعني، بأي معنى من المعاني، التطاولَ على أسلافنا أو تحجيمَ شأو علمائنا؛ بل يعني، فيما يعنيه، أن تقديرَهم يتبدى أساساً في محاورتِهم والتعاملِ اليقِظِ مع اجتهاداتهم، بشكلٍ يضمنُ الوفاءَ لروحِ هذا الاجتهادِ الملائِمِ لمقتضياتِ وأسئلة عصرهم، لا الجمودَ الشكلي والحرفي والنصي على نتائجِ هذه الاجتهاداتِ التي ارتبطت بطبيعةِ هذه الأسئلة في زمان ومكان ومقتضياتٍ ثقافية وتاريخية واجتماعية وعلمية مُحدَّدَةٍ؛ مما يعني أن التجاوزَ هو أرقى أشكالِ الوفاءِ[3]، لأن الوفاءَ إما أن يكون نقديا أو لا يكون[4]، ولا تجاوزَ بغيرِ استيعابٍ، لذا يُوكَلُ هذا الشأنُ لأهلهِ من المختصينَ المؤهلينَ لمثلِ هذا الوفاء.
المدخلُ الثاني، في التناول الذي نرومهُ لتلك “الأسئلة الحرجة”، يتمثلُ في ضرورةِ التمييزِ الإجرائي، مبدئيا، بين ثلاثِ مقارباتٍ إسلاميةٍ هي الأبرز في التعامل مع النص الديني: “مقاربةٌ سلفيةٌ حرفية” و”مقاربةٌ إصلاحية” و”مقاربة تأويلية”. أما الأولى فترى أن “الفهمَ الحرفيّ” للنص الديني يُمثِّلُ حقيقةَ الدين وحَقيقةَ موقفِهِ من المرأةِ، وأن لا إمكانَ لمراجعةِ هذا الفهمِ لأنهُ مُعبِّر عن كمال الدين وخاتميةِ الرسالة، وأنهُ مطابقٌ لما جاء في الكتابِ والسنَّةِ ولمُرادِ الشارعِ، وأنْ لا فهمَ أرقى من فهمِ “السلفِ” للنقلِ، فهُمْ ثقاةٌ مُتقون، وأرجحُ منا في الفهم السليم للكتاب والسنةِ وتطبيقِهما، وما سواهُ من فهوم، أكانت قديمةً أم حديثةً، ليست سوى زيغٍ وانحراف وضلال عن منهج “الفرقة الناجية” التي يمثلها “أهلُ السنة والجماعة” بالنسبة للجناح السُّني، و”أهلُ العصمة والعدالة” بالنسبةِ للجناح الشيعي. بخلاف هذا، تحاول “المقاربةُ الإصلاحيةُ” إعمالَ العقلِ لشرحِ وتعليلِ وتبرير كثيرٍ من “الأحكام” من أجل بيانِ احترامِها لحقوقِ المرأةِ، والردّ على جملة من التُّهم والشبهاتِ المثارةِ حول هذه الحقوقِ[5]، ومن ثمَّ القولُ بأسبقيةِ الإسلامِ في تكريمِ المرأةِ والعنايةِ بها قبل القوانينِ الوضعيةِ الغربية. وتتميزُ هذه المقاربةُ باستعمال المحاجة العقلية في تعليلِ وتبرير الأحكامِ، ولا تقفُ عندَ حرفيةِ النصوص كما هو شأنُ “المقاربةِ السلفيةِ الحرفية”، بل تستدعي من الأدلةِ ما بهِ تدعمُ وتقوي الفهمَ الفقهي التقليدي وتُسوِّغُه في الخطاب الديني المعاصر.
أما “المقاربةُ التأويليةُ” فتذهبُ أبعد من هذا، حيثُ تعملُ على إعادةِ النظرِ في فهمِ النصوصِ التأسيسيةِ نفسِها، وذلك بتقديم قراءةٍ ترتكنُ إلى أدواتٍ منهجية غير تقليدانيةٍ في فهمِ الدين، كردّ الأحكام الفقهيةِ الجزئية إلى كليةِ التصور الإسلامي الذي لا يقيمُ تمييزا أنطولوجيا بين الرجل والمرأةِ، وقراءةِ النصوص الدينيةِ وتفسيراتها في ضوء السياقِ التاريخي والثقافي والأنتروبولوجي لنزول الوحي ولتفسيراته المتعددة؛ قراءة تهتدي أيضا بوعي هيرمينوطيقي من أجل تَجاوزِ ما تعتبرُه فهما “أبويا” للدينِ جعلَ الفقهَ “ذكوريَّ” النزعةِ وظيفتُهُ تبريرُ واقعٍ ثقافي سابق على الوحيِ فيهِ يتسيَدُ الرجلُ ويستأسد. وهذا الفهم “الأبوي”، في نظر هذه القراءة، هو ما طمسَ البذورَ التحرريةَ الثوريةَ التي تتضمنها نصوص الوحي حيال وضعِ المرأةِ[6]، تلكَ البذور التي تقتضي تناولا تأويليا جديداً يُثَوِّرُ هذا الفهمَ ويُنوِّرهُ لتحقيقِ تحررِ المرأةِ بالقرآنِ ومن خلالهِ. وعن هذه الرؤية يصدرُ، مثلا في الجناح السنِّي، تأويلٌ مقاصدي ذو تحليل اتجاهي[7] للآيات المتعلقة بالمرأة في القرآن الكريم[8]، وتصدر، مثلا في الجناح الشيعي، قراءةٌ جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الديني تشمل المفاهيم والتصورات مثلما تطول الأحكام والحقوق[9]؛ كما تصدرُ عن تلك الرؤيةِ التأويليةِ أيضاً كتاباتُ ما صار يسمى اليوم بـ”النسوية – أوالحركة النسائية – الإسلامية”، ومن أعلامها أسماء نسائية بارزة، على ما بينها من تفاوت في درجةِ الطرح لا في طبيعته؛ مثل المغربيتين فاطمة المرنيسي[10] وأسماء المرابط[11]، والأفرو أمريكة أمينة ودود، والباكستانيتين أسماء بارلاس ورفعت حسن…إلخ[12].
يقودنا التمييزُ المبدئي بين المقارباتِ الثلاث إلى مدخل ثالثٍ أخالُهُ ضرورياً لكل محاولةٍ تستقصِدُ تنويرَ فهم “مكانة المرأة في الإسلام”، وهي إعطاءُ الاعتبار إلى الصوتِ النسائي في هذا الفهم، والإصغاءُ إلى الـمرأة باعتبارها “ذاتاً” مُفكرةً وليست فقط “موضوعا” للتفكير، وهو ما يعني رفع الوصاية الفكرية “الذكورية” عن المرأة؛ خصوصا بعد التحولات التعليمية والثقافية والتواصلية الكبرى التي عرفتها المجتمعات المعاصرة، والتي أثمرت لنا نساءً متعلماتٍ ومثقفاتٍ ومتخصصات في شتى أصنافِ الـمعارف والعلوم، بما فيها الحقول المعرفية الإسلامية المختلفةُ، مما أهَّل الـمرأة لتقدم اجتهاداتٍ عميقةً في فهم مكانتها في الإسلام انطلاقا من أماكن قرائية مختلفة عن تلك المألوفةِ في الـمقاربتين “السلفية” و”الإصلاحية”. نحتاجُ اليوم إلى الإنصات إلى هذه الاجتهادات والحوار مع هذه الأصوات النسائية، سواء تلك التي ترمي إلى إعادة صياغة الموقف الديني حيال المرأة انطلاقا من مقاربة تأويلية نسوية إسلامية؛ أو تلك الأصوات الرافضة التي تقرأ بنــــوع من الغضب والرفض النصوص الدينية التأسيسية نفسَها باعتبارها مؤسِّسَة للوضـع الدونـــي للمرأةِ، وهــــو ما أُطلِقَ عليهِ “نســــوية إسلامية رافضة”[13]؛ أو تلك التي ترفض بشكل جذري هذه “النسوية”، وتعتبرُ أن مفهوم “النسوية الإسلامية” مثله مثل “النسوية المسيحية أو اليهودية، يحتوي على تناقض ضمني يُقوِّضُ مفعولَه وهدفَه”[14]، وهذا منزعٌ إلحاديٌّ ُيعلنَ بوضـوحٍ “إلحاديتهُ”[15] معلِّلاً ذلكَ بالمكانة المُهينة التي تتبوأها المرأة في سائرِ الأديان السماوية[16].
إن الإصغاء لهذه الأصوات النسائية المختلفة ينقلنا من السؤال المطروح المألوف: “كيف ينظرُ الإسلام إلى المرأة؟”، إلى سؤال آخر منسيّ في فكرنا السائدِ هو: “كيف تنظر المرأةُ، اليوم، إلى مكانتِها في الإسلام؟” وهو ما من شأنه أن يؤزّمَ النظرةَ “الذكورية” للموضوع، ويضطرّ الفكرَ إلى إعادة فتحِ كثير من “الأسئلة الحرجة” المشار إلى بعضها آنفا من زوايا أخرى للنظر؛ سواء تعلق الأمر بـ”المقاربة التأويلية”، والتي تُعَد تثويرا لفهم مكانة المرأة في الإسلام من داخل الدينِ؛ أو تعلق الأمرُ بـالمقاربتين “الرافضة” و”الإلحادية”، واللتين تعتنقان رفض “التعامل الديني مع المرأة”؛ سواء بشكل جزئي يتصل برفض بعض النصوص التأسيسية الإسلامية المتعلقة بالمرأة في “المقاربة الرافضة”، أو بشكل جذري يشمل كل النصوص الدينية المقدسة كما تطرح ذلك “المقاربة الإلحادية
يتبع ….
********
[1]– بث البرنامج في حلقتين بتاريخ 17 و24-05-2013م.
[2]– الإشارةُ هنا إلى الصالون الثالث من صالونات “نادي الإبداع والفكر” الذي تنظمه شهريا الرئيسة المؤسسة للنادي الأستاذة سعدى ماء العينين. وقد عُقِدَ يوم الخميس 13-03- 2014 بمعهد بردج بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حول موضوع: “نزهة في رحاب المرأة في الديانات السماوية، الروضة الأولى: المرأة في الإسلام”. وعرفَ مداخلتين عميقتين: الأولى للدكتورة سعيدة بناني حول “دور المرأة الأمريكية المسلمة في مخاض التعددية”، والثانية للدكتور عبد الله شريف الوزاني حول “المرأة المسلمة والأسئلة الحرجة”، تلاهما نقاشٌ غني يشي بمدى حاجتنا إلى طرح كثير من القضايا التي تبدو “بديهية”. وكم كان عنوانُ الأستاذ الوزاني موفقاً وهو يشيرُ إلى مسألة “الإحراجية” التي تطبعُ الأسئلة المثارةَ اليوم حول مكانة المرأة في الإسلام، والتي حصرها في المسائل السبع المذكورة.
[3]– حدجامي، عادل، “فلسفة جيل دولوز، عن الوجود والاختلاف“، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 2012، ص.48.
[4]– “سياسات الضيافة، شذرات من خطاب الغيرية“، م.س، ص. 160.
[5]– كثيرة هي الشواهد على هذه المقاربة، ويمكننا التمثيل لها بـ: عمارة، محمد، “حقائق وشبهات حول مكانة المرأة في الإسلام“، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2010.
[6]– ظهرت هذه البذور أيضا في بعض القراءات الاستثنائية الجريئة التي تخللت تراثَنا الإسلامي، وطالت النصين التأسيسين من زوايا تأويلية عرفانية وذوقية. وقد حاولت هذه القراءاتُ إبرازَ المكانة الرفيعة للمرأة في المنظومة الإسلامية، بل وتجاوزَ “ذكورية” الفقه من الداخل، وذلك بتقديم فهم روحاني لكثير من الأحكام الفقهية انطلاقا من تمثلٍ عميق لمفهوم “الأنوثة” في الأنطولوجيا الإسلامية. راجع مثلا: براضة، نزهة، “الأنوثة في فكر ابن عربي“، دار الساقي، بيروت 2008.
[7]– بخصوص الأبعاد المعرفية والمنهجية لهذه القراءة المقاصدية، راجع كتاب: الطالبي، محمد، “عيال الله، أفكار جديدة عن علاقات المسلم بنفسه وبالآخرين“، دار سراس للنشر، تونس 1992، ص.142-145.
[8]– قدم الأستاذ محمد الطالبي قراءة تاريخية للآيتين 34 و35 من سورة النساء، تتناول وفق التأويل المقاصدي قضيةَ تأديب المرأة بالضرب، راجع كتابه: “أمة الوسط، الإسلام وتحديات العصر“، دارسراس للنشر، تونس 2006م، ص.115-141.
[9]– راجع: القبانجي، أحمد، “المرأة، المفاهيم والحقوق، قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الديني“، دار الانتشار العربي، بيروت2009.
[10]– راجع مثلا:
Mernissi, Fatima, “Le harem politique : le Prophète et les femmes“, Albin Michel, 1987, Paperback 1992.
[11]– راجع مثلا: المرابط، أسماء، “القرآن والنساء، قراءة للتحرر“، ترجمة محمد الفران، مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام (الرابطة المحمدية للعلماء)، الرباط 2010م.
[12]– راجع بخصوص بعض هذه الطروحات: جدعان، فهمي، “خارج السرب، مقالات في النسوية الإسلامية الرافضة وإغراءات الحرية“، الشبكة العربة للأبحاث والنشر، ط 2، بيروت 2012م، ص.23-82.
[13]– راجع بالخصوص آراء الأوغاندية إرشاد منجي في: “خارج السرب“، م.س، ص.155-174.
[14]– حداد، جمانة، “سوبرمان عربي (مع مقدمة خاصة للطبعة العربية: لماذا أنا ملحدة)”، دار الساقي، 2014م، ص.96.
[15]– ربما كان الأجدر أن تُصنَّف ضمن هذا المنزعِ آراءُ البنغالية تسليمة نسرين والصومالة أيان حرسي علي، لا ضمن “النسوية الإسلامية الرافضة” كما ذهب إلى ذلك د.جدعان في كتابه “خارج السرب“، فالإقرار بمنزعهما الإلحادي الصريح وفير في الكتاب نفسه (راجع مثلا: “خارج السرب“، م.س، ص.104؛ 109؛ 110؛ 113 – بالنسبة لتسليمة نسرين-، ص.124؛ 130؛ 132؛ 134 -بالنسبة لأيان حرسي علي-). وهذا بخلاف إرشاد منجي التي لم تفقد الأمل في الإسلام، بل إنها ما تفتأ تُعلن تمسكها بإيمانها وتبنيها لإصلاح الإسلام من الداخل (“خارج السرب“: ص. 156، 167-168).
[16]– “سوبرمان عربي“، م.س، ص.16-22.