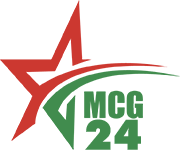إعداد: محمد بن الطاهر المودن
مقدمة
الخطيبي: ” أديب وعالم اجتماع مغربي، تخصص في الأدب المغاربي، وقدم أطروحات نقدية وتصورات فكرية أثارت ردود أفعال متفاوتة، اهتم بتحليل النظم الثقافية المادية والرمزية، وظل يبحث عن الخيوط المشتركة التي بإمكانها توحيد العالم العربي” والإسلامي، قيل عنه إنه: ” الأنثروبولوجي الذي عاش غريبا ومات غريبا ” ، لكن شمس العلم والفكر والأدب تأبى الغروب حتى تضيء الطريق للسائرين في نورها.
الخطيبي
ولد عبد الكبير الخطيبي يوم 11 فبراير/ 1938 بمدينة الجديدة المغربية (جنوب الدار البيضاء)، التحق بإعدادية سيدي محمد بمراكش عام 1950، ثم انتقل إلى ثانوية ليوطي بالدار البيضاء، حيث حصل على البكالوريا عام 1957. وفي عام 1959 بدأ دراسة علم الاجتماع والفلسفة في جامعة السوربون بباريس، حيث حصل على الدكتوراه عام 1965 حول “الأدب المغاربي”.
تقلد الخطيبي عدة مناصب أكاديمية، حيث شغل أستاذا جامعيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ثم مديرا لمعهد السوسيولوجيا السابق بنفس المدينة، وعين بعدها مديرا للمعهد الجامعي للبحث العلمي، ثم عمل رئيسا لتحرير “المجلة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب”، و مدير مجلة “علامات الحاضر”.
كان منهج الخطيبي “متفردا” في العالم العربي، والكتابة بالنسبة إليه مغامرة تقتضي تفكيك الأشياء وممارسة النقد المزدوج للتراث ولمعرفة الآخرين، وتقتضي إلغاء الحدود المصطنعة بين الأجناس الأدبية وبين أنواع الكتابة.
قال عنه رولان بارت “إنني والخطيبي نهتم بأشياء واحدة، بالصور والأدلة والآثار، وبالحروف والعلامات. وفي الوقت نفسه يعلمني الخطيبي جديداً، يخلخل معرفتي، لأنه يغيّر هذه الأشكال، كما أراه يأخذني بعيدا عن ذاتي، إلى أرضه هو، في حين أحسّ كأني في الطرف الأقصى من نفسي”.
وفي السياق نفسه يقول الروائي محمد برادة: “إن نقد الرواية جزء من مغامرة الكتابة عند الخطيبي، وهو عندما نشر دراسته عن الرواية في بلدان المغرب العربي عام 1968، كانت معظم الدراسات النقدية المكتوبة باللغة العربية تتخذ من النقد وسيلة لإمرار بعض التصورات الأيديولوجية المسبقة، أو لتكرار وصفات مدرسية عن المذاهب والاتجاهات الأدبية”.
كتب الخطيبي في مجالات مختلفة، في القصة والشعر، والنقد الأدبي والمسرح، ونشر قصصا وكتبا ودراسات كثيرة حول المجتمع والفن في العالم الإسلامي، وقد أصدر روايته الأولى “الذاكرة الموشومة” عام 1971.
ومن أهم مؤلفاته “فن الخط العربي” عام 1976، و”الرواية المغاربية” عام 1993، و”المغرب أفقا للفكر” عام 1993، و”صور الأجنبي في الأدب الفرنسي”، و”المناضل الطبقي على الطريقة التاوية” عام 1976، ومسرحية “النبي الخفي” عام 1979، وقد ترجمت أعماله إلى عدة لغات.
فاز عبد الكبير الخطيبي بجوائز عديدة منها، جائزة الأدب في الدورة الثانية لمهرجان “لازيو بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط” في إيطاليا، عن مجمل أعماله، وجائزة “الربيع الكبرى” التي تمنحها جمعية “أهل الأدب” الفرنسية.
توفي عبد الكبير الخطيبي يوم 16 مارس/ 2009 في أحد مستشفيات الرباط، عن عمر يناهز 71 ” .
صورة المغربي
اهتم الخطيب كثيرا في دراساته وكتاباته بالحداثة وقضاياها، بالمثقف والمدينة، والمغرب العربي، والقيم المشتركة التي يمكن أن يؤسس عليها، والهوية وصورة العربي عن نفسه، مع التأكيد على ضرورة الاستعمال الحسن للدين لقيام الوحدة العربية والمغاربية، وقد أفرد في كتابه: ” المغرب العربي وقضايا الحداثة ” فصلا تحدث فيه عن الهوية وصورة العربي عن نفسه، وآخر خصه بصورة المغربي، وقد رصدت الدراسة هذه المعطيات عن الصورة الذي يكونها المغربي عن نفسه كما رآها الخطيبي.
1. المغربي قبل التقنية
يرى الخطيبي أن الناس في قبل ــ يعني قبل عصر التقنية ــ كانوا : ” يتركون للشمس ولأوقات الصلاة عبء تنظيم سير أنشطتهم وأوقات فراغهم، وكان الجسد يتابع إيقاعه الطبيعي والبطيء كما لو كان نبتة .. ومن هذه الحقبة المديدة احتفظ المغرب بقيم حضارية ذات قيمة كبرى، وقد خضعت تلك القيم طيلة القرون السالفة للتحول، تحت تأثير التحضر والسيولة التبادلية، وكذا بالاشتغال على الأرض .. فبين الفلاح والمحارب، وبينه وبين الولي، وبين هذ الأخير والتاجر، توجد حركة تنقل مكثفة ومستمرة لقوى البلاد التي استقرت عليها ونظمتها تقاليد الملكية” .
2. المغربي بعد التقنية
المغربي بعد عصر التقنية والسرعة يقول عنه الخطيبي: ” واكتشف المغربي السرعة والارتجاج بحيرة بالغة، هكذا نراه يجري لكي يصل متأخرا، وهو يصل دائما متأخرا، والخطأ في ذلك يعود إلى الآخر، فالمغربي يتنصل من الخطأ بتفويض سحري”، ويمثل لهذا الأمر بسائق مغربي وسلوكه أمام الضوء الأحمر فيقول: ” لتنظروا إلى سائق أمام الضوء الأحمر، فهو إذا لم يتجاوزه، يتوقف تاركا إياه وراء ظهره، فالحيلة البصرية للمغربي تكمن في عدم رؤية القانون وجها لوجه، وبذلك يكون احترام القانون وخرفه متواشجين في النظرة نفسها، والحركة نفسه، إن لدى المغربي رغبة عميقة في محو وتعطيل الحدود بينهما” .
3. المغربي اجتماعي بالفطرة
يرى الخطيبي أن المغربي اجتماعيا بالفطرة وجماعيا بالتقليد، ويصفه في جميع أحواله الاجتماعية والنفسية والعلائقية فيقول: ” إن المغربي باعتباره جماعيا بالفطرة واجتماعيا بالتقليد، يكن احتراما مبالغا فيه للتراتبية والأوتوقراطية، إنه يملك مهارة عائلته ومجموعته وفن الاحتفال، إضافة إلى الكلمة النبيلة، والتعابير الجاهزة، فهو تارة ينمحي أمام السلطة، ويتآلف معها تارة أخرى، ومن حوث كونه مسالما ومحبا للظواهر، يغدو جافا وصامتا حين تفاجئه عاصفة الأحداث، وحين يكتم غيظه تراه يشبه صخرة نحتتها جبال الأطلس، أما حين يثور فإنه يكنس كل ما يعترض طريقه ” .
4. المغربي والعزلة
المغربي لا يكره شيئا كرهه للعزلة إذ تشكل له كابوسا، فالموت أهون عليه من العزلة يقول عنه الخطيبي: ” أكره ما يكره المغربي هو العزل عن المجموعة، فالعزلة في نظره كابوس، إذ إنه وهو على فراش الموت، لا يحس بأن ذويه قد هجروه، من ثم تأتي تلك النظرة القلقة ذات المسحة الكئيبة، إنه التوازن بين عشق الحياة وتقديس الموتى” .
خاتمة
الخطيبي لم يعش غريبا ولم يمت غريبا، عاش فاعلا في المجتمع متأثرا به ومؤثرا فيه وإن بصمت، عاش حياة الأنثروبولوجين، يرقبون حركة المجتمع منصتين له يتأملون أحواله، يرصدون ماضيه ويرسمون له مستقبله، الاشتغال بصمت يترك صدى لا يمحى، أما من يشتغل بضوضاء فينتهي بانتهائها، إنه الخطيبي الذي يعرفه الغرب والشرق قبل المغرب.
الملاحق
1 موقع: https://www.aljazeera.net/
2 موقع: https://www.febrayer.com/
3 موقع: https://www.aljazeera.net/ بتصرف.
4 عبد الكبير الخطيبي: المغرب العربي وقضايا الحداثة ص 72 بتصرف. ترجمة فريد الزاهي.
5 نفسه ص 72 وما بعدها بتصرف.
6 نفسه ص 73.
7 نفسه ص 74.