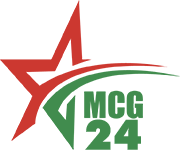صورة الأشعري والأشعرية في فكر المستشرق الألماني
مراد هوفمان[1]
إعداد محمد بن الطاهر المودن
باحث في العقيدة والفكر الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
وبعد.
مقدمة
ينطلق المستشرق[2] الألماني الدكتور مراد هوفمان، من حقيقة فحواها أن وسائل النظر واحدة ومشتركة بين جميع البشر، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية، وهويتهم الفكرية، وإن اختلفت نتائج نظرهم، فـ ” العالم الذي يراقبه الماركسيون، واللبراليون، والمسلمون، هو عالم واحد، كذلك أدوات الحس لديهم واحدة، إنهم يبصرون بالعيون نفسها، ويفكرون بالعقول نفسها، ومع ذلك، فإنهم يصلون إلى نتائج متباينة للعقول، حول حدود الإدراك الحسي، وطبيعة الكون، وهندسته، وحول مصير الإنسان “[3].
كما يؤكد على أن نظرة المسلمين للعالم ذات ترابط وعقلانية مثل نظرات الآخرين، إلا أنها تنفرد بتأسيسها على كتاب، ألا وهو القرآن الكريم، وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
المقاربة الأشعرية لوجود الله وذاته.
قارب الدكتور مراد هوفمان مسألة الإيمان بالله في وجوده وذاته وصفاته مبرزا أهم خصائص النظر الأشعري ومميزاته في مقابل المقاربة الاعتزالية مركزا على النظر الأشعري من خلال المؤسس أبي الحسن الأشعري[4]، ومطورها أبي حامد الغزالي[5].
- وجود الله وذاته:
بهذا الصدد ينطلق من مسلمات داخل العالم الإسلامي، ويعتبر أن وجود الله وذاته، نادرا ما يكون موضوعا للمناقشة، ويعتبرها من المسلمات، مقدما قصة العجوز مع أبي حامد الغزالي، حين قيل لها: ” إن أبا حامد الغزالي قدم ألف دليل على وجود الله، فكانت إجابتها الخالدة: ” وما ذا بعد؟ ما لم يكن لديه ألف شك، ما كان عليه البحث على ألف دليل “.[6]
- قاعدة ” بلا كيف ولا تشبيه ” لدى الأشعرية
يعود سبب الغياب النسبي لنقاش وجود الله بين المسلمين، إلى يقينهم بأن الله فوق التصور، شديد المحال، أبدي، لا يحده مكان ولا زمان، لذا فهو يتجاوز الفهم الإنساني، توصلوا إلى هذه النتيجة مع الفلسفة ” غير الميتافيزيقية ” للفيلسوف المسلم أبي الحسن الأشعري فيقول: ” لقد وضع الأشعري نهاية صارمة للتخمينات الفلسفية للهلينستية الجديدة التي دخلت إلى الإسلام عن طريق المعتزلة الذين يمثلون مدرسة علم الكلام. لقد وصل المعتزلة بالفعل إلى الموقف الي لا يمكن تبريره، بتعريض القرآن للنظر العقلي، في قضايا فكرية خلافية، مثل أبدية العالم، وفي خلق القرآن، والاختيار والجبر، إلى الحد الذي يجعل اعتبار الحكم البشري الخاص بهم هو المرجعية العظمى التي يجب ان تسود “[7].
على النقيض من التجربة الفلسفية الاعتزالية هاته، ” اختارت مدرسة الأشعرية قبول الصعوبة، بقاعدة: ” بلا كيف ولا تشبيه “، بمعنى بدون البحث والتقصي ولا المقارنة بهذا الصدد، باستخدام هذا التخمين النظري المعرفي الفطري، وضع الأشعرية ومن بعدهم الغزالي النهاية للماورائيات في العالم الإسلامي “[8].
- الغزالي ونقده للفلسفة العقلانية
وما يثير إعجابه في تجربة الأشعرية هو: ” إدراك الأشعرية لاستحالة الحصول على برهان استقرائي لقانون العلية ( السببية )، … بهذا وجه الغزالي ضربة قاضية إلى التخمين الميتافيزيقي، وإلى نظرية الوجود تقوم بالكلية على الحدس، عندما أدرك أن مداركه العقلية كانت تقوده نحو نهاية لا يمكن تجاوزها. فإن الغزالي قام بتحول تام في آرائه بإصدار كتابه التاريخي ” تهافت الفلاسفة “، في هذا الكتاب أشار الغزالي بكل رضا، إلى أن الأنظمة الفلسفية المعروفة، فلسفة الكندي، والرازي، والفارابي، وابن سنا، تقوم على قواعد مفترضة وغير قابلة للتوضيح، وبذلك لا يمكن الاعتماد عليها “[9].
وفي خطوة ثانية، امتد انتقاد الغزالي للعقلانية ليشمل الرياضيات، والمنطق، وفلسفة التشريع، وعلم الإلهيات أيضا. لقد كثف من رؤاه في سيرته الذاتية ” المنقذ من الضلال “، التي تحوى ” الاعترافات ” الشهيرة عن محاكمته الذاتية المرهقة. على الإجمال، أنكر الغزالي قدرة أي علم على توفير البصيرة النافذة في أي حقيقة غير محسوسة، وشدد على أن كل العلوم قامت على قواعد بديهية غير معصومة من الخطأ، الرياضيات، في مفهومه تتيح فقط نتائج دورانية متكررة لا تقدم مزيدا من الوضوح، المنطق، لا يحتوي على قيمة معرفية أو إدراكية، حيث لا يمكن العثور على قيود صحيحة عامة ملزمة له، هكذا، فإن كل معارفنا عن العالم غير المرئي، ناتجة عن افتراضات لا يمكن إثباتها، .. لأن الدين ليس مسألة إقامة دليل، بل مسألة إيمان “[10].
- الغزالي والتجربة العرفانية
وفي النهاية بعد أن فند العقلانية بأدلة عقلانية، أكد الغزالي على وجود طريق واحد إلى المعرفة: الحدس الصوفي باعتبار: ” الإلهام هو حالة خاصة تكتشف فيها العين الداخلية .. الأسرار التي يستحيل على العقل الوصول إليها “، ” أنا مدين في حكمي، ليس إلى سلسلة الأدلة والبراهين، ولكن إلى النور الذي قذفه الله في قلبي “[11].
وهكذا، فقد توصل الغزالي إلى اليقين بوجود الله، وإلى صدق النبوة، ” ليس من خلال البرهان العقلي، ولكن بواسطة تداعي الأسباب والظروف، والبراهين التي من المستحيل سردها “، هذا الطريق بعد إغلاق الباب على التساؤل العقلي، تركه الفلاسفة المسلمون مفتوحا بشكل شخصي للغاية، ومقصورا على فئة قليلة للاقتراب من الحقيقة المطلقة “[12].
إلى يومنا هذا، ظلت تلك هي الخلفية الفلسفية للإيمان ــ غير التخميني للمسلمين ــ بوجود الله الواحد الأحد والواحد ـ التوحيد ـ، لذلك فالمناقشات عن الله داخل العالم الإسلامي لا ترتكز على وجود الله، أو ذاته، وبدلا من ذلك ترتكز على صفات الكمال المختصة به، كما أوحى بها القرآن، وجاءت به السنة “[13].
خاتمة
يبدو أن مراد هوفمان قدم صورة موجزة عن الأشعري والأشعرية مبرزا أهم خصائصها ومميزاتها مستعرضا منهج أبي حامد الغزالي ورحلته المعرفية الذاتية وانتقاله من العقلانية إلى التجربة العرفانية، بهذه السردية البسيطة اختزل هوفمان صورة مصغرة عن الأشعري والأشعرية وطرق معرفة وجود الله والإيمان به في الفكر الأشعري.
المراجع:
ملاحظة: المادة العلمية مأخوذة من هذا الكتاب: خواء الذات والأدمغة المستعمرة، للمستشرق الألماني: مراد ويلفريد هوفمان. مكتبة الشروق الدولية ط 2/ 2011 ترجمة عادل المعلم ونشأت جعفر. ص 83 وما بعدها بتصرف. باستثناء ترجمة الأعلام ولفظ الاستشراق فإني عرفت بهم للتنوير لا أقل. ويحق للموقع حذفهم إن كان يرى أنه لا داعي للتعريف بهم ويكتفي بالمصدر العلمي للمقال.
1 ترجمته: مراد ويلفريد هوفمان (بالألمانية: Murad Wilfried Hofmann) (6 يوليو 1931 في أشافنبورغ – 13 يناير 2020 في بون. كان محامياً ودبلوماسياً وكاتباً ألمانياً. اعتنق هوفمان الإسلام عام 1980. قام بتأليف العديد من الكتب عن الإسلام، منها رحلة إلى مكة المكرمة والإسلام: البديل. تركزت العديد من كتبه ومقالاته على وضع الإسلام في الغرب، وبعد 11 سبتمبر على وجه الخصوص، في الولايات المتحدة. كما أنه أحد الموقعين على “مبادرة كلمة سواء“، وهي رسالة مفتوحة لعلماء المسلمين للقادة المسيحيين، تدعو إلى السلام والتفاهم.
2 تعريف الاستشراق: الاستشراق (Orientalism) هو دراسة كافّة البنى الثّقافيّة للشّرق من وجهة نظر غربية. وتستخدم كلمة الاستشراق أيضاً لتدليل تقليد أو تصوير جانب من الحضارات الشرقية لدى الرواة والفنانين في الغرب.
3 4 الأشعري: أحد أعلام أهل السنة والجماعة، وإليه ينسب المذهب الأشعري، وكنيته أبو الحسن ويلقب بناصر الدين، وينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري. (260هـ – 324هـ = 874م – 936م)
5 الغزالي: أبو حامد محمد الغزّالي الطوسي النيسابوري الصوفي الشافعي الأشعري، أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري، (450 هـ – 505 هـ / 1058م – 1111م).
6 مرجع سابق ص 84.
7 نفسه.
8 نفسه 85
9 نفسه.
10 نفسه ص 86
11 نفسه 86
12 نفسه
13 نفسه ص 8 بتصرف.